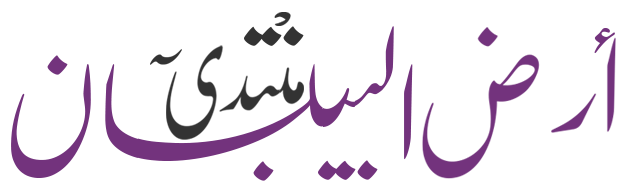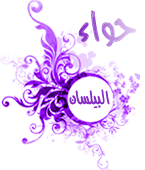عاشق الوسوف

وزير البيلسان


- إنضم
- Oct 9, 2008
- المشاركات
- 11,971
- مستوى التفاعل
- 89
- المطرح
- مملكه الوسوف


شخصيات صنعت تاريخا
 [FONT=Arial (Arabic)]ابــن النفيـس[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ابــن النفيـس[/FONT]


[FONT=Arial (Arabic)]هو علاء الدين بن أبي الحزم القرشي الشافعي، الطبيب المصري المعروف بابن النفيس. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]لم يذكر المؤرخون تاريخاً لميلاده على وجه الدقة، إنما يرجع مولده إلى سنة 608 هـ، وقد عاش ابن النفيس في مدينة دمشق.. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]اشتهر ابن النفيس بالطب، ويعد رائداً فيه، خاصة في أبحاثه عن الدورة الدموية. وكغيره من علماء العرب، لم تقتصر أبحاثه على الطب، بل تعدت للمنطق والفلسفة واللغة والبيان والحديث وأصول الفقه. وقد توفى على أغلب الأقوال في سنة 689 هـ بعد قضائه حياة حافلة بالانتاج العلمي.. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]من أهم ما خلفه ابن النفيس (الموجز) وهو ملحق لقانون ابن سينا (وشريح تشريح القانون)، وفيه بدء التشريح المقارن، ويشير في مقدمته إلى مصادره التي نقل عنها. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]امتاز منهج ابن النفيس بأصالة الرأي واستقلال الفكر، واعتمد في دراساته على المشاهدة والتجربة. أما المشاهدة فمعناها تتبع الظواهر واستخلاص الحقائق الكاملة عنها. وأما التجربة فهي خلق حالات يتحكم فيها العالم من أجل دراسة تأثير عامل معين.. وكثيراً ما ترتبط ظاهرة ما بعوامل عدة، فيلجأ الباحث إلى إجراء التجربة التي لا يسمح فيها إلا بتغير عامل واحد، بينما يتحكم هو في العوامل الأخرى ويثبتها.. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]فإذا قلنا مثلاً أن حجم الغاز يتغير بتغير درجة حرارته وبتغير ضغطه، فإن العالم يستطيع، عن طريق التجارب، أن يثبت درجة الحرارة ليدرس العلاقة القائمة بين الحجم والضغط .. وعلى هذا النحو كان عمل ابن النفيس في مجال الطب، إذ ركز أبحاثه على دراسة الظواهر والعوامل المؤثرة في الجسم، أكثر من اهتمامه بموضوع الطب العالجي فكان بذلك أول من صنف هذا النوع من الدراسة، مما جعله رائداً وعالماً في وظائف الأعضاء.. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]من أهم ما أنجزه ابن النفيس أعمال من سبقوه وأخضعها للمشاهدة والتجربة.. فأخذ السليم منها، والذي يماشي الطبيعة ويطابق الواقع، ونبذ ما لم يقبله عقله. وهذا ما ساعده على أن يسبق أهل عصره بعد ما وضع نظريات وآراء يأخذ بها العلم الحديث. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]قال ابن النفيس أن الدم يخرج من البطين الأيمن للرئتين، حيث يمتزج بالهواء، ثم يعود إلى البطين الأيسر.. وهذه هي الدورة الدموية الصغرى التي بها ينقى الدم في الرئتين من أجل استمرار الحياة واكتساب الجسم القدرة على العمل. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وعلى هذا النحو يعد ابن النفيس المعلم الأول الذي نقل عنه الطبيب البريطاني (هارفي) مكتشف الدورة الدموية الكبرى عام 1628م. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]جدير بالذكر أن الرأي الذي كان سائداً قبل ابن النفيس هو أن الدم يتولد من الكبد، ومنه ينتقل إلى البطين الأيمن في القلب ثم يسري بعد ذلك في الأوردة ومنه إلى مختلف أعضاء الجسم فيغذيها ويجدد فيها النشاط والحيوية.. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ومن الأفكار القديمة أن قسماً من الدم يدخل البطين الأيسر عن طريق مسام في الحجاب الحاجز حيث يمتزج بالهواء المقبل من الرئتين، وينساب المزيج إلى مختلف أعضاء الجسم.. وبذلك لم يعرف أطباء القرون الوسطى حقيقة الدورة الدموية لكن ابن النفيس عارض تلك الآراء ونقضها، وعلى رأسها أراء جالينوس وابن سينا .. وبذلك يكون ابن النفيس قد وضع أساساً عظيماً في مجال الطب باكتشافه الدورة الدموية الصغرى التي على أثرها تطور الطب وتقدمت وسائل العلاج حتى عصرنا الحاضر..[/FONT]
=========================
 [FONT=Arial (Arabic)]خليل السكاكيني[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]خليل السكاكيني[/FONT]


[FONT=Arial (Arabic)]عاش في الفترة ما بين عامي (1878 - 1953) وهو لغوي معلم وكاتب عربي، ولد في القدس وتعلم وسافر إلى انجلترا وأمريكا. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]أنشأ مدراس في فلسطين وجدد في طريقة التعليم فأدخل طريقة (الكلمة) في تعليم المبتدئين بكتابه (الجديد) 1924. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]دعا إلى التجديد في لغة الكتابة بسلسلة من المقالات والمحاضرات جمعها في كتاب (مطالعات في اللغة والأدب) عام 1925 وتقوم دعوة السكاكيني على إيثار السهولة والوضوح والإقتصاد. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ومن كتبه (فلسطين بعد الحرب الكبرى) و (ما تيسر) (جزءان). [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]كان عضواً في المجمع العلمي بدمشق والمجمع اللغوي بالقاهرة. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]نشرت ابنته هالة 1960 مذكرات شخصيته بقلمه (كذا أنا يا دنيا) تظهر أسلوبه الطيع، وتقصى جهاده وفجيعته في ابنه سري وقد مات بعد وفاته ببضعة أشهر حزناً عليه.[/FONT]
=========================
 [FONT=Arial (Arabic)]ابن خلدون[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ابن خلدون[/FONT]


[FONT=Arial (Arabic)]هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الذي ولد وتوفي في الفترة بين ( 1332- 1406) وهو مؤرخ وفيلسوف اجتماعي ، عربي مسلم ، ينتهي نسبه الى وائل بن حجر من عرب اليمن .[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]أقامت أسرته في تونس ، حيث ولد ونشأ وتعلم بها ثم تنقل في بلاد المغرب والأندلس ، ثم أقام بتلمسان ، وشرع في تأليف تاريخه ، وبعدها عاد الى تونس ، ومنها انتقل الى مصر ، واتصل بسلطانها برقوق ، فولاه القضاء ، انقطع للتدريس و التأليف فأتم كتابه (العبر وديوان المبتدأ والخبر) وهو كتاب له قيمة كبرى بين كتب التاريخ الإسلامي كما أن لمقدمته خطر عظيم لإشتمالها على فصول في أصول العمران ، والنظريات الاجتماعية و السياسية ، وتصنيف العلوم وغير ذلك مما جعل من ابن خلدون مؤسسا لفلسفة التاريخ و علم الاجتماع الذي يقول عنه أنه فرع فلسفي جديد لم يخطر على قلب أرسطو . [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]قال ابن خلدون في مقدمته : (إن كثيرين قبله حوموا على الغرض ولم يصادفوه ، ولا تحققوا قصده ، ولا استوفوا مسائله) . وأمل ابن خلدون ممن يأتون من بعده أن يستمروا في البحث ، فيتمموا ما فاته من المسائل ، وتحقق أمله بالفعل ولكن على أيدي الفلاسفة الغربيين أمثال فيكو وأوجست..[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)] ولابن خلدون آراء طريفة في التربية فقد خصص الباب السادس ومنها (المقدمة) للبحث في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه ، وسائر وجوهه وتعرض لاختلاف الأمصار الإسلامية في طرق التعليم ، وانتقد البدء بتعليم القرآن والاقتصار عليه ، لأن الأطفال يقرأون مالا يفهمون ، فلا تحصل لهم الملكة اللغوية. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وحاول ابن خلدون أن يرشد الى وجه الصواب في التعليم ، فأشار الى ضرورة إجمال المسائل في البداية ، والتفصيل فيما بعد ، والإعتماد على الأمثلة الحسية. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ومن الموضوعات الطريفة التي تعمق ابن خلدون في دراستها : علاقة الفكر بالعمل وتكوين الملكات والعادات عن طريق المحاكاة والتلقين المباشر والتكرار ، وقد أحسن ابن خلدون في الدعوة للرحمة بالأطفال ، وفي معارضته استعمال الشدة اتجاههم فبين المفاسد الخلقية التي تنجم عن القسوة وقال أن القهر العسف يقضي كلاهما على انبساط النفس ونشاطها ، ويدعو الى الكسل ، ويحمل على الكذب والخبث والمكر والخديعة ، ويفسد معاني الإنسانية ومن المؤسف أن آراء ابن خلدون السديدة في التربية والتعليم ، لم يظهر لها أي تأثير في مجتمعه في العصور التالية.[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]واستعرض ابن خلدون تاريخ الحركة الفكرية لدى المسلمون وسعى الى الكشف عن العلاقة بين العلوم والآداب من جهة والتطوير الاجتماعي من جهة أخرى ، وأوضح أن التربية ظاهرة اجتماعية و أن التعليم يتطور مع تطور العمران .[/FONT]
=========================
 [FONT=Arial (Arabic)]ابن سينا[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ابن سينا[/FONT]


[FONT=Arial (Arabic)]هو أبو علي الحسين بن عبدالله بن سينا ولد في أفشنة، قرب بخارى سنة 980م، درس العلوم العقلية والشرعية، وأصبح حجة في الطب والفلك والرياضة والفلسفة، ولم يبلغ العشرين عاماً، ظل ابن سينا يتنقل بين قصور الأمراء يشتغل بالتعليم والسياسة وتدبير شؤون الدولة، حتى توفي سنة 1036م ودفن بهمذان.[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]تجاوزت مصنفاته المائتين، بين كتب ورسائل تدل على سعة ثقافته وبراعته في العلوم الفلسفية وغيرها، منها (الشفاء) و (النجاة) وهو مختصر للشفاء والإشارات والتنبيهات، ولخصه الفخر الرازي بعنوان (لباب الإشارات). [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ظل ابن سينا عمدة الأطباء طيلة العصور الوسطى ، كما ظل أعظم عالم بالطب منذ 1100 - 1500م. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]الجسم عند ابن سينا ليس فاعلاً، فالفاعل انما يكون قوة أو صورة أو نفساً، والانسان مؤلف من نفس وبدن، تفيض عليه النفس من واهب الصور وهو العقل الفعال وللنفس قوى أفضلها النظرية، وبها تعتقل المعقولات، أما العالم المحسوس، فتعرفه النفس بواسطة الحواس الظاهرة والباطنة، وأعلى قوة النفس النظرية: العقل الذي يكون أولاً عقلاً بالقوة، ثم يصير عقلاً بالفعل، بمعونة العقل الفعال. وبعد الموت، تبقى النفس متصلة بالعقل (الكلى) وسعادة النفس الخيرة في اتحادها بالفعل الفعال، والشقاء الأبدي من حظ النفوس غير الخيرة. وبقدر حظ النفس من المعرفة والصحة في الدنيا، يكون حظها من الثواب في الآخرة، وقد عرض ابن سينا لدرحات العارفين وحظوظهم من البهجة والسعادة، فانتهى إلى أن أصحاب المعارف واللذات العقلية هم أسعد العارفين، ويوفق الفيلسوف بين الفلسفة والدين، بما حاوله من تأويل عقلي لآيات القرآن الكريم ، وبما أورده من أدلة عقلية لإثبات النبوة وضروراتها الاجتماعية لتدبير أمور الناس في معاشهم، وتبصيرهم بحقائق حياتهم في معادلهم.[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وابن سينا في علم النفس كثيراً ما تعرض لمسائل تتعلق بالتربية والتعليم: فهو يشير إلى أهمية الانتباه في تذكر الاحساسات، إذ يقول أن الصبيان يحفظون جيداً لأن نفوسهم غير مشغولة بما تشغل نفوس البالغين. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وقد تكلم ابن سينا على التربية مباشرة في رسالة صغيرة عن السياسة، وخصص الفصل الرابع منها لسياسة الرجل مع ولده. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وحس ابن سينا أن يباشر بالتعليم إلا بعد تجاوز الطفل السادسة حتى تشتد مفاصله، ويعي سمعه، وألا يحمل عى ملازمة الكتاب مرة واحدة.[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ويدعو الأطفال بعد المرحلة الأولى من التعليم وتوجيه كل منهم حسب ميوله واستعداداته، كما يراعي الناحية العلمية في التربية واعداد الناشئين لكسب المعاش. ولابن سينا جزء هام في علم الموسيقى، من جملة الرياضيات في كتابه (الشفاء) وله أيضاً مختصر في الموسيقى ضمن كتابه (النجاة).[/FONT]
=========================
 [FONT=Arial (Arabic)]ابن رشد[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ابن رشد[/FONT]


[FONT=Arial (Arabic)]هو أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد الذي ولد وتوفي في الفترة (1126 - 1198) وهو فيلسوف وطبيب وفقيه من أصل عربي أندلسي ولد بقرطبة، وحذق في العلوم الشرعية والعقلية، ولى القضاء في مدينة إشبيلية، ثم في قرطبة، فشغل منصب أبيه وجده، وأصبح يلقب بقاضي قرطبة.. لقب ابن رشد ب(الشارح) لشرحه كتب أرسطو، بتكليف من أمير الموحدين (أبي يعقوب يوسف) ، الذي عرف ابن رشد عن طريق ابن طفيل، فأكبره وقربه منه. وعندما أصبحت الفلسفة موضعاً للسخط، اضطُهد ابن رشد، ونفى في (أليسانة) قرب قرطبة، ثم عفا الأمير عنه، فعاد الفيلسوف إلى مراكش، حيث عاجلته المنية هناك. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]شرح ابن رشد كتباً كثيرة لأرسطو منها (الطبيعيات) و (السماء) و (العالم) و (الكون والفساد) و (الآثار العلوية) و (النفس), ومن أهم شروح ابن رشد: (تفسير ما بعد الطبيعة لأرسطو). [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]أهم مصنفاته الفلسفية: (تهافت التهافت) الذي رد فيه على كتاب الغزالي (تهافت الفلاسفة) وقد عنى الفيلسوف بالتوفيق بين الفلسفة والدين، وبإثبات أن الشريعة الإسلامية حثت على النظر العقلي وأوجبته، وأنها والفلسفة حق والحق لا يضاد الحق، بل يؤيده ويشهد له ، ولهذا وضع رسالتين: أحدهما (فصل المقال فيما بين الحكم والشريعة من الاتصال) والأخرى (الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة) وله في الطب كتاب (الكليات) الذي كان له شأن في العصور الوسطى وقد ألفه ليقابل به كتاب (التيسير) لمعاصره أبي مروان بن زهر الذي عني ببحث الجزيئيات.[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]تدور فلسفة ابن رشد على قدم العالم وأنه مخلوق، وأن الخلق خلق متجدد، به يدوم العالم ويتغير، وأن الله فاعل الكل وموجده، والحافظ له، وذلك بتوسط العقول المحركة للأفلاك. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وعنده أن علم الله منزه عن أن يكون علماً بالجزيئيات الحادثة المتغيرة المعلومة أو علماً بالكليات التي تنتزع من الجزيئيات، فكلا العلمين بالجزيئيات والكليات حادث ومعلول، أما علم الله فعلم يوجد العالم ويحيط به، فيكفي أن يعلم الله في ذاته الشيء ليوجد، ولتدوم عناية الله به، وحفظه الوجود عليه. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وعنده أن العقل الفعال، الذي يفيض المعقولات على العقل الإنساني، أزلي وأن العقل الإنساني، بحكم اتصاله بالعقل الفعال وإفاضة هذا العقل عليه، أبدى هو الآخر، أما النفس، فصورة الجسم تفارقه وتبقى بعده منفردة وأما الجسد الذي كان سيبعث فهو ليس عين الجسد الذي كان لكل إنسان في الحياة، وإنما هو جسد يشبهه، وأكثر كمالاً منه. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]يرى ابن رشد أن يعمل الإنسان على إسعاد المجموع، فلا يخص شخصه بالخير والبر، وأن تقوم المرأة بخدمة المجتمع والدولة، كما يقوم الرجل، وأن المصلحة العامة هي مقياس قيم الأفعال من حيث الخير والشر وإن كان العمل خيراً أو شراً لذاته، وكان العمل الخلقي هو ما يصدر عن عقل وروية من الإنسان. وليس الدين عنده مذاهب نظرية، بل هو أحكام شرعية، وغايات خلقية، بتحقيقها يؤدي الدين رسالته، في خضوع الناس لأوامرهن وانتهائهم عن نواهيه. [/FONT]
=========================
 [FONT=Arial (Arabic)]ابــن زيــدون[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ابــن زيــدون[/FONT]


[FONT=Arial (Arabic)]هو أبو الوليد أحمد بن زيدون المخزومي الأندلسي، ولد في قرطبة سنة 394هـ ونشأ في بيئة علم وأدب، توفي أبوه، وهو في الحادية عشرة من عمره، فكفله جده وساعده على تحصيل علوم عصره فدرس الفقه والتفسير والحديث والمنطق، كما تعمق باللغة والأدب وتاريخ العرب، فنبغ في الشعر والنثر. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وشهد ابن زيدون تداعي الخلافة الأموية في الأندلس، فساعد أحد أشراف قرطبة وهو ابن الحزم جهور للوصول إلى الحكم، أصبح ابن زيدون وزير الحاكم الجديد ولقب بذي الوزارتين. ثم أقام ابن زيدون علاقة وثيقة بشاعرة العصر وسيدة الظرف والأناقة ولادة بنت المستكفي أحد ملوك بني أمية، وكانت قد جعلت منزلها منتدى لرجال السياسة والأدب، وإلى مجلسها كان يتردد ابن زيدون، فقوي بينهما الحب، وملأت أخبارهما وأشعارهما كتب الأدب، وتعددت مراسلاتهما الشعرية. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ولم يكن بد في هذا الحب السعيد من الغيرة والحسد والمزاحمة، فبرز بين الحساد الوزير ابن عبدوس الملقب بالفار، وكان يقصر عن ابن زيدون أدباً وظرفاً وأناقة، ويفوقه دهاء ومقدرة على الدس فكانت لإبن عبدوس محاولات للإيقاع بين الحبيبين لم يكتب لها النجاح. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ونجحت السعاية للإيقاع بين ابن زيدون وأميره فنكب الشاعر وطرح في السجن. ولم تنفع قصائد الاستعطاف التي وجهها من السجن إلى سيده فعمد ابن زيدون إلى الحيلة وفر من السجن واختفى في بعض ضواحي قرطبة. وعبثاً حاول استرضاء ولادة التي مالت أثناء غيابه إلى غريمه ابن عبدوس. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ولما تسلم أبو الوليد أمر قرطبة بعد وفاة والده أبي الحزم أعاد ابن زيدون إلى مركزه السابق لكن شاعرنا أحس فيما بعد بتغير الأمير الجديد عليه بتأثير من الحساد، فترك البلاط وغادر المدينة. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ووصل ابن زيدون مدينة إشبيلية حيث بنو عباد، فلقي استقبالاً حاراً وجعله المعتضد بن عباد وزيره، وهكذا كان شأنه مع ابنه المعتمد. وكان حب ولادة لا يزال يلاحقه، على الرغم من تقدمهما في السجن، فكتب إليها محاولاً استرضاءها فلم يلق صدى لمحاولاته وقد يعود صمتها إلى نقمتها على ابن زيدون بسبب ميله إلى جارية لها سوداء أو أن ابن عبدوس حال دون عودتها إلى غريمه، والمعروف أن ولادة عمرت أيام المعتمد ولم تتزوج قط. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وبترغيب من ابن زيدون احتل المعتمد بن عباد مدينة قرطبة وضمها إلى ملكه وجعلها مقره فعاد الشاعر إلى مدينته وزيراً قوياً فهابه الخصوم وسر به المحبون، إلا أنه لم يهنأ بسعادته الجديدة. إذ ثارت فتنة في إشبيلية فأرسل ابن زيدون إليها لتهدئة الحال. بتزيين من الخصوم قصد أبعاده، فوصل ابن زيدون مدينة إِشبيلية. وكان قد أسن، فمرض فيها ومات سنة 463 هـ / 1069 م. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]لابن زيدون ديوان شعر حافل بالقصائد المتنوعة، طبع غير مرة في القاهرة وبيروت وأهم ما يضمه قصائدة الغزلية المستوحاة من حبه لولادة، وهو غزل يمتاز بصدق العاطفة وعفوية التعبير وجمال التصوير، ومن بين تلك القصائد (النونية) المشهورة التي نسج اللاحقون على منوالها ومطلعها: [/FONT] [FONT=Arial (Arabic)]أضحى التنائي بديلاً من تنادينا ...... وناب عن طيب لقيانا تجافينا[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ومن الأبيات الواردة في القصيدة:[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]يكاد حين تناجيكم ضمائرنا ...... يقضي علينا الأسى لولا تأسينا [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]حالت لفقدكم أيامنا فغدت ...... سوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]إن الزمان الذي ما زال يضحكنا ...... أنساً بقربكم قد عاد يبكينا [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]سران في خاطر الظلماء يكتمنا ...... حتى يكاد لسان الصبح يفشينا[/FONT] [FONT=Arial (Arabic)]وبعد فراره من السجن قصد مدينة الزهراء في إحدى ضواحي قرطبة وتأمل طبيعة افتقد جمالها في السجن، فتذكر ولادة ونظم قصيدة مطلعها: [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]إني ذكرتك بالزهراء مشتاقاً ...... والأفق طلق ومرأى الأرض قد راقا [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وفي ديوان ابن زيدون مدائح كثيرة في بني جمهور وبني عباد وفيه مطارحات بينه وبين ولادة ومساجلات بينه وبين المعتمد بن عباد. وأوصاف لمشاهد الطبيعة ورثاء واستعطاف وشكاوى كلها تحعل ابن زيدون من كبار شعراء الأندلس. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]أما نثره فلا يقل عن شعره قيمة فلم يصلنا منه سوى رسالتين تبينان قوة ملكته اللغوية وعمق ثقافته ولكن قلة انتاجه النثري جعل ابن زيدون في مصاف الشعراء وقلما يذكر بين الكتاب والمعروفين. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]أما الرسالتان النثريتان فالأولى منهما تهكمية وضعها على لسان ولادة ووجهها إلى ابن عبدوس غريمه في الحب وخصمه في السياسة وقد استرسل فيها وأطال وضمنها أخبار العرب وأشعارهم، وما استطاع لسانه السليط أن يوفر من نابي اللفظ الرسالة وقد اشتهرت رسالة ابن زيدون التهكمية وعدت مثالاً للبلاغة ونموذجاً للنقد المتهكم.. وفي مستهلها يقول ابن زيدون: [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)](أما بعد أيها المصاب بعقله، المورط بجهله البين سقطه، الفاحش غلطه العاثر في ذيل اغتراره، الأعمى عن شمس نهاره ... الساقط سقوط الذباب على الشراب، المتهافت تهافت الفراش في الشهاب، فإن العجب أكذب ومعرفة المرء نفسه أصوب ... ). [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]أما الثانية فهي الرسالة الجدية التي كتبها في سجنه إلى الأمير أبي الحزم بن جمهور يتنصل فيها من التهم الموجهة إليه ويستعطف أميره ويذكره بإخلاصه له، ويختمها بقصيدة تعد من أجمل ما نظم في الإستعطاف. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وصفوة القول أن ابن زيدون هو علم من أعلام الأدب العربي. شعره ونثره وقد يصح فيه قول ابن بسام في كتابه (الذخيرة): (كان أبو الوليد خاتمة شعراء بني مخزوم وأحد من خبر الأيام خبراً ووسع البيان نظماً ونثراً ... )[/FONT]
=========================
 [FONT=Arial (Arabic)][SIZE=+1]عباس محمود العقاد[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)][SIZE=+1]عباس محمود العقاد[/SIZE][/FONT]


[FONT=Arial (Arabic)]العقاد شاعر وكاتب مصري ، ولد بأسوان سنة 1889م وبعد أن أتم وظيفة كتابية لم يلبث أن تركها، اشتغل بالصحافة وأقبل على تثقيف نفسه ثقافة واسعة. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]بدأ إنتاجه الشعري قبل الحرب العالمية الأولى وظهرت الطبعة الأولى من ديوانه سنة 1916م والطبعة الثانية سنة 1928م في أربعة أجزاء، وتوالت بعد ذلك مجموعاته الشعرية بعناوين مختلفة : (وحي الأربعين) و (هدية الكروان) و (عابر سبيل) ..[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]العقاد يعني بأصالة الشعور والفكر حتى حين كان ينظم في المناسبات، ويرى أن العناية بالصياغة وحدها لا تنتج شعراً له قيمة، وقد ارتاد للشعر العربي آفاقاً جديدة،فلم يكتف بالشعر القصصي، بل اتخذ من البيئة المصرية ومشاهد الحياة العادية مصادر للإلهام، ولتأكيد هذا المذهب خاض العقاد الناقد معارك شديدة مع أنصار القديم، تتمثل حدتها الأولى في كتاب اشترك فيه المازني، وصدر باسم (الديوان) سنة 1921م، [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]عنى العقاد بابن الرومي، وكتب عنه كتاباً كبيراً وقد غلب فن المقالة على انتاج العقاد .. النثر الأول: (الفصول)، مطالعات في الكتب والحياة، (مراجعات الآداب والفنون)، ثم كتب سلسلة سير الأعلام في الإسلام بطريقة خاصة أشبه برسم الشخصيات: (عبقرية محمد) و (عبقرية عمر) وغيرهما، ورواية واحدة (سارة)، واتجه العقاد إلى الفلسفة والدين ومن مؤلفاته (الله) و (الفلسفة القرآنية)، و (ابليس) ..[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]في عنفوان نشاط الوفد المصري كان العقاد يكتب الافتتاحيات السياسية في جرائده، مثل (البلاغ) و (الجهاد) وكتب سيرة للزعيم سعد باشا زغلول سنة 1936م. وصدرت عن العقاد عدة بحوث أهمها للآن كتاب بقلم تلاميذه..[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]توفي العقاد سنة 1964م عن خمسة وسبعين عاماً. [/FONT]
=========================
يتبع ....






[FONT=Arial (Arabic)]هو علاء الدين بن أبي الحزم القرشي الشافعي، الطبيب المصري المعروف بابن النفيس. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]لم يذكر المؤرخون تاريخاً لميلاده على وجه الدقة، إنما يرجع مولده إلى سنة 608 هـ، وقد عاش ابن النفيس في مدينة دمشق.. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]اشتهر ابن النفيس بالطب، ويعد رائداً فيه، خاصة في أبحاثه عن الدورة الدموية. وكغيره من علماء العرب، لم تقتصر أبحاثه على الطب، بل تعدت للمنطق والفلسفة واللغة والبيان والحديث وأصول الفقه. وقد توفى على أغلب الأقوال في سنة 689 هـ بعد قضائه حياة حافلة بالانتاج العلمي.. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]من أهم ما خلفه ابن النفيس (الموجز) وهو ملحق لقانون ابن سينا (وشريح تشريح القانون)، وفيه بدء التشريح المقارن، ويشير في مقدمته إلى مصادره التي نقل عنها. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]امتاز منهج ابن النفيس بأصالة الرأي واستقلال الفكر، واعتمد في دراساته على المشاهدة والتجربة. أما المشاهدة فمعناها تتبع الظواهر واستخلاص الحقائق الكاملة عنها. وأما التجربة فهي خلق حالات يتحكم فيها العالم من أجل دراسة تأثير عامل معين.. وكثيراً ما ترتبط ظاهرة ما بعوامل عدة، فيلجأ الباحث إلى إجراء التجربة التي لا يسمح فيها إلا بتغير عامل واحد، بينما يتحكم هو في العوامل الأخرى ويثبتها.. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]فإذا قلنا مثلاً أن حجم الغاز يتغير بتغير درجة حرارته وبتغير ضغطه، فإن العالم يستطيع، عن طريق التجارب، أن يثبت درجة الحرارة ليدرس العلاقة القائمة بين الحجم والضغط .. وعلى هذا النحو كان عمل ابن النفيس في مجال الطب، إذ ركز أبحاثه على دراسة الظواهر والعوامل المؤثرة في الجسم، أكثر من اهتمامه بموضوع الطب العالجي فكان بذلك أول من صنف هذا النوع من الدراسة، مما جعله رائداً وعالماً في وظائف الأعضاء.. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]من أهم ما أنجزه ابن النفيس أعمال من سبقوه وأخضعها للمشاهدة والتجربة.. فأخذ السليم منها، والذي يماشي الطبيعة ويطابق الواقع، ونبذ ما لم يقبله عقله. وهذا ما ساعده على أن يسبق أهل عصره بعد ما وضع نظريات وآراء يأخذ بها العلم الحديث. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]قال ابن النفيس أن الدم يخرج من البطين الأيمن للرئتين، حيث يمتزج بالهواء، ثم يعود إلى البطين الأيسر.. وهذه هي الدورة الدموية الصغرى التي بها ينقى الدم في الرئتين من أجل استمرار الحياة واكتساب الجسم القدرة على العمل. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وعلى هذا النحو يعد ابن النفيس المعلم الأول الذي نقل عنه الطبيب البريطاني (هارفي) مكتشف الدورة الدموية الكبرى عام 1628م. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]جدير بالذكر أن الرأي الذي كان سائداً قبل ابن النفيس هو أن الدم يتولد من الكبد، ومنه ينتقل إلى البطين الأيمن في القلب ثم يسري بعد ذلك في الأوردة ومنه إلى مختلف أعضاء الجسم فيغذيها ويجدد فيها النشاط والحيوية.. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ومن الأفكار القديمة أن قسماً من الدم يدخل البطين الأيسر عن طريق مسام في الحجاب الحاجز حيث يمتزج بالهواء المقبل من الرئتين، وينساب المزيج إلى مختلف أعضاء الجسم.. وبذلك لم يعرف أطباء القرون الوسطى حقيقة الدورة الدموية لكن ابن النفيس عارض تلك الآراء ونقضها، وعلى رأسها أراء جالينوس وابن سينا .. وبذلك يكون ابن النفيس قد وضع أساساً عظيماً في مجال الطب باكتشافه الدورة الدموية الصغرى التي على أثرها تطور الطب وتقدمت وسائل العلاج حتى عصرنا الحاضر..[/FONT]
=========================



[FONT=Arial (Arabic)]عاش في الفترة ما بين عامي (1878 - 1953) وهو لغوي معلم وكاتب عربي، ولد في القدس وتعلم وسافر إلى انجلترا وأمريكا. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]أنشأ مدراس في فلسطين وجدد في طريقة التعليم فأدخل طريقة (الكلمة) في تعليم المبتدئين بكتابه (الجديد) 1924. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]دعا إلى التجديد في لغة الكتابة بسلسلة من المقالات والمحاضرات جمعها في كتاب (مطالعات في اللغة والأدب) عام 1925 وتقوم دعوة السكاكيني على إيثار السهولة والوضوح والإقتصاد. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ومن كتبه (فلسطين بعد الحرب الكبرى) و (ما تيسر) (جزءان). [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]كان عضواً في المجمع العلمي بدمشق والمجمع اللغوي بالقاهرة. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]نشرت ابنته هالة 1960 مذكرات شخصيته بقلمه (كذا أنا يا دنيا) تظهر أسلوبه الطيع، وتقصى جهاده وفجيعته في ابنه سري وقد مات بعد وفاته ببضعة أشهر حزناً عليه.[/FONT]
=========================



[FONT=Arial (Arabic)]هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الذي ولد وتوفي في الفترة بين ( 1332- 1406) وهو مؤرخ وفيلسوف اجتماعي ، عربي مسلم ، ينتهي نسبه الى وائل بن حجر من عرب اليمن .[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]أقامت أسرته في تونس ، حيث ولد ونشأ وتعلم بها ثم تنقل في بلاد المغرب والأندلس ، ثم أقام بتلمسان ، وشرع في تأليف تاريخه ، وبعدها عاد الى تونس ، ومنها انتقل الى مصر ، واتصل بسلطانها برقوق ، فولاه القضاء ، انقطع للتدريس و التأليف فأتم كتابه (العبر وديوان المبتدأ والخبر) وهو كتاب له قيمة كبرى بين كتب التاريخ الإسلامي كما أن لمقدمته خطر عظيم لإشتمالها على فصول في أصول العمران ، والنظريات الاجتماعية و السياسية ، وتصنيف العلوم وغير ذلك مما جعل من ابن خلدون مؤسسا لفلسفة التاريخ و علم الاجتماع الذي يقول عنه أنه فرع فلسفي جديد لم يخطر على قلب أرسطو . [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]قال ابن خلدون في مقدمته : (إن كثيرين قبله حوموا على الغرض ولم يصادفوه ، ولا تحققوا قصده ، ولا استوفوا مسائله) . وأمل ابن خلدون ممن يأتون من بعده أن يستمروا في البحث ، فيتمموا ما فاته من المسائل ، وتحقق أمله بالفعل ولكن على أيدي الفلاسفة الغربيين أمثال فيكو وأوجست..[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)] ولابن خلدون آراء طريفة في التربية فقد خصص الباب السادس ومنها (المقدمة) للبحث في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه ، وسائر وجوهه وتعرض لاختلاف الأمصار الإسلامية في طرق التعليم ، وانتقد البدء بتعليم القرآن والاقتصار عليه ، لأن الأطفال يقرأون مالا يفهمون ، فلا تحصل لهم الملكة اللغوية. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وحاول ابن خلدون أن يرشد الى وجه الصواب في التعليم ، فأشار الى ضرورة إجمال المسائل في البداية ، والتفصيل فيما بعد ، والإعتماد على الأمثلة الحسية. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ومن الموضوعات الطريفة التي تعمق ابن خلدون في دراستها : علاقة الفكر بالعمل وتكوين الملكات والعادات عن طريق المحاكاة والتلقين المباشر والتكرار ، وقد أحسن ابن خلدون في الدعوة للرحمة بالأطفال ، وفي معارضته استعمال الشدة اتجاههم فبين المفاسد الخلقية التي تنجم عن القسوة وقال أن القهر العسف يقضي كلاهما على انبساط النفس ونشاطها ، ويدعو الى الكسل ، ويحمل على الكذب والخبث والمكر والخديعة ، ويفسد معاني الإنسانية ومن المؤسف أن آراء ابن خلدون السديدة في التربية والتعليم ، لم يظهر لها أي تأثير في مجتمعه في العصور التالية.[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]واستعرض ابن خلدون تاريخ الحركة الفكرية لدى المسلمون وسعى الى الكشف عن العلاقة بين العلوم والآداب من جهة والتطوير الاجتماعي من جهة أخرى ، وأوضح أن التربية ظاهرة اجتماعية و أن التعليم يتطور مع تطور العمران .[/FONT]
=========================



[FONT=Arial (Arabic)]هو أبو علي الحسين بن عبدالله بن سينا ولد في أفشنة، قرب بخارى سنة 980م، درس العلوم العقلية والشرعية، وأصبح حجة في الطب والفلك والرياضة والفلسفة، ولم يبلغ العشرين عاماً، ظل ابن سينا يتنقل بين قصور الأمراء يشتغل بالتعليم والسياسة وتدبير شؤون الدولة، حتى توفي سنة 1036م ودفن بهمذان.[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]تجاوزت مصنفاته المائتين، بين كتب ورسائل تدل على سعة ثقافته وبراعته في العلوم الفلسفية وغيرها، منها (الشفاء) و (النجاة) وهو مختصر للشفاء والإشارات والتنبيهات، ولخصه الفخر الرازي بعنوان (لباب الإشارات). [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ظل ابن سينا عمدة الأطباء طيلة العصور الوسطى ، كما ظل أعظم عالم بالطب منذ 1100 - 1500م. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]الجسم عند ابن سينا ليس فاعلاً، فالفاعل انما يكون قوة أو صورة أو نفساً، والانسان مؤلف من نفس وبدن، تفيض عليه النفس من واهب الصور وهو العقل الفعال وللنفس قوى أفضلها النظرية، وبها تعتقل المعقولات، أما العالم المحسوس، فتعرفه النفس بواسطة الحواس الظاهرة والباطنة، وأعلى قوة النفس النظرية: العقل الذي يكون أولاً عقلاً بالقوة، ثم يصير عقلاً بالفعل، بمعونة العقل الفعال. وبعد الموت، تبقى النفس متصلة بالعقل (الكلى) وسعادة النفس الخيرة في اتحادها بالفعل الفعال، والشقاء الأبدي من حظ النفوس غير الخيرة. وبقدر حظ النفس من المعرفة والصحة في الدنيا، يكون حظها من الثواب في الآخرة، وقد عرض ابن سينا لدرحات العارفين وحظوظهم من البهجة والسعادة، فانتهى إلى أن أصحاب المعارف واللذات العقلية هم أسعد العارفين، ويوفق الفيلسوف بين الفلسفة والدين، بما حاوله من تأويل عقلي لآيات القرآن الكريم ، وبما أورده من أدلة عقلية لإثبات النبوة وضروراتها الاجتماعية لتدبير أمور الناس في معاشهم، وتبصيرهم بحقائق حياتهم في معادلهم.[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وابن سينا في علم النفس كثيراً ما تعرض لمسائل تتعلق بالتربية والتعليم: فهو يشير إلى أهمية الانتباه في تذكر الاحساسات، إذ يقول أن الصبيان يحفظون جيداً لأن نفوسهم غير مشغولة بما تشغل نفوس البالغين. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وقد تكلم ابن سينا على التربية مباشرة في رسالة صغيرة عن السياسة، وخصص الفصل الرابع منها لسياسة الرجل مع ولده. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وحس ابن سينا أن يباشر بالتعليم إلا بعد تجاوز الطفل السادسة حتى تشتد مفاصله، ويعي سمعه، وألا يحمل عى ملازمة الكتاب مرة واحدة.[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ويدعو الأطفال بعد المرحلة الأولى من التعليم وتوجيه كل منهم حسب ميوله واستعداداته، كما يراعي الناحية العلمية في التربية واعداد الناشئين لكسب المعاش. ولابن سينا جزء هام في علم الموسيقى، من جملة الرياضيات في كتابه (الشفاء) وله أيضاً مختصر في الموسيقى ضمن كتابه (النجاة).[/FONT]
=========================



[FONT=Arial (Arabic)]هو أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد الذي ولد وتوفي في الفترة (1126 - 1198) وهو فيلسوف وطبيب وفقيه من أصل عربي أندلسي ولد بقرطبة، وحذق في العلوم الشرعية والعقلية، ولى القضاء في مدينة إشبيلية، ثم في قرطبة، فشغل منصب أبيه وجده، وأصبح يلقب بقاضي قرطبة.. لقب ابن رشد ب(الشارح) لشرحه كتب أرسطو، بتكليف من أمير الموحدين (أبي يعقوب يوسف) ، الذي عرف ابن رشد عن طريق ابن طفيل، فأكبره وقربه منه. وعندما أصبحت الفلسفة موضعاً للسخط، اضطُهد ابن رشد، ونفى في (أليسانة) قرب قرطبة، ثم عفا الأمير عنه، فعاد الفيلسوف إلى مراكش، حيث عاجلته المنية هناك. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]شرح ابن رشد كتباً كثيرة لأرسطو منها (الطبيعيات) و (السماء) و (العالم) و (الكون والفساد) و (الآثار العلوية) و (النفس), ومن أهم شروح ابن رشد: (تفسير ما بعد الطبيعة لأرسطو). [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]أهم مصنفاته الفلسفية: (تهافت التهافت) الذي رد فيه على كتاب الغزالي (تهافت الفلاسفة) وقد عنى الفيلسوف بالتوفيق بين الفلسفة والدين، وبإثبات أن الشريعة الإسلامية حثت على النظر العقلي وأوجبته، وأنها والفلسفة حق والحق لا يضاد الحق، بل يؤيده ويشهد له ، ولهذا وضع رسالتين: أحدهما (فصل المقال فيما بين الحكم والشريعة من الاتصال) والأخرى (الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة) وله في الطب كتاب (الكليات) الذي كان له شأن في العصور الوسطى وقد ألفه ليقابل به كتاب (التيسير) لمعاصره أبي مروان بن زهر الذي عني ببحث الجزيئيات.[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]تدور فلسفة ابن رشد على قدم العالم وأنه مخلوق، وأن الخلق خلق متجدد، به يدوم العالم ويتغير، وأن الله فاعل الكل وموجده، والحافظ له، وذلك بتوسط العقول المحركة للأفلاك. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وعنده أن علم الله منزه عن أن يكون علماً بالجزيئيات الحادثة المتغيرة المعلومة أو علماً بالكليات التي تنتزع من الجزيئيات، فكلا العلمين بالجزيئيات والكليات حادث ومعلول، أما علم الله فعلم يوجد العالم ويحيط به، فيكفي أن يعلم الله في ذاته الشيء ليوجد، ولتدوم عناية الله به، وحفظه الوجود عليه. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وعنده أن العقل الفعال، الذي يفيض المعقولات على العقل الإنساني، أزلي وأن العقل الإنساني، بحكم اتصاله بالعقل الفعال وإفاضة هذا العقل عليه، أبدى هو الآخر، أما النفس، فصورة الجسم تفارقه وتبقى بعده منفردة وأما الجسد الذي كان سيبعث فهو ليس عين الجسد الذي كان لكل إنسان في الحياة، وإنما هو جسد يشبهه، وأكثر كمالاً منه. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]يرى ابن رشد أن يعمل الإنسان على إسعاد المجموع، فلا يخص شخصه بالخير والبر، وأن تقوم المرأة بخدمة المجتمع والدولة، كما يقوم الرجل، وأن المصلحة العامة هي مقياس قيم الأفعال من حيث الخير والشر وإن كان العمل خيراً أو شراً لذاته، وكان العمل الخلقي هو ما يصدر عن عقل وروية من الإنسان. وليس الدين عنده مذاهب نظرية، بل هو أحكام شرعية، وغايات خلقية، بتحقيقها يؤدي الدين رسالته، في خضوع الناس لأوامرهن وانتهائهم عن نواهيه. [/FONT]
=========================



[FONT=Arial (Arabic)]هو أبو الوليد أحمد بن زيدون المخزومي الأندلسي، ولد في قرطبة سنة 394هـ ونشأ في بيئة علم وأدب، توفي أبوه، وهو في الحادية عشرة من عمره، فكفله جده وساعده على تحصيل علوم عصره فدرس الفقه والتفسير والحديث والمنطق، كما تعمق باللغة والأدب وتاريخ العرب، فنبغ في الشعر والنثر. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وشهد ابن زيدون تداعي الخلافة الأموية في الأندلس، فساعد أحد أشراف قرطبة وهو ابن الحزم جهور للوصول إلى الحكم، أصبح ابن زيدون وزير الحاكم الجديد ولقب بذي الوزارتين. ثم أقام ابن زيدون علاقة وثيقة بشاعرة العصر وسيدة الظرف والأناقة ولادة بنت المستكفي أحد ملوك بني أمية، وكانت قد جعلت منزلها منتدى لرجال السياسة والأدب، وإلى مجلسها كان يتردد ابن زيدون، فقوي بينهما الحب، وملأت أخبارهما وأشعارهما كتب الأدب، وتعددت مراسلاتهما الشعرية. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ولم يكن بد في هذا الحب السعيد من الغيرة والحسد والمزاحمة، فبرز بين الحساد الوزير ابن عبدوس الملقب بالفار، وكان يقصر عن ابن زيدون أدباً وظرفاً وأناقة، ويفوقه دهاء ومقدرة على الدس فكانت لإبن عبدوس محاولات للإيقاع بين الحبيبين لم يكتب لها النجاح. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ونجحت السعاية للإيقاع بين ابن زيدون وأميره فنكب الشاعر وطرح في السجن. ولم تنفع قصائد الاستعطاف التي وجهها من السجن إلى سيده فعمد ابن زيدون إلى الحيلة وفر من السجن واختفى في بعض ضواحي قرطبة. وعبثاً حاول استرضاء ولادة التي مالت أثناء غيابه إلى غريمه ابن عبدوس. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ولما تسلم أبو الوليد أمر قرطبة بعد وفاة والده أبي الحزم أعاد ابن زيدون إلى مركزه السابق لكن شاعرنا أحس فيما بعد بتغير الأمير الجديد عليه بتأثير من الحساد، فترك البلاط وغادر المدينة. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ووصل ابن زيدون مدينة إشبيلية حيث بنو عباد، فلقي استقبالاً حاراً وجعله المعتضد بن عباد وزيره، وهكذا كان شأنه مع ابنه المعتمد. وكان حب ولادة لا يزال يلاحقه، على الرغم من تقدمهما في السجن، فكتب إليها محاولاً استرضاءها فلم يلق صدى لمحاولاته وقد يعود صمتها إلى نقمتها على ابن زيدون بسبب ميله إلى جارية لها سوداء أو أن ابن عبدوس حال دون عودتها إلى غريمه، والمعروف أن ولادة عمرت أيام المعتمد ولم تتزوج قط. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وبترغيب من ابن زيدون احتل المعتمد بن عباد مدينة قرطبة وضمها إلى ملكه وجعلها مقره فعاد الشاعر إلى مدينته وزيراً قوياً فهابه الخصوم وسر به المحبون، إلا أنه لم يهنأ بسعادته الجديدة. إذ ثارت فتنة في إشبيلية فأرسل ابن زيدون إليها لتهدئة الحال. بتزيين من الخصوم قصد أبعاده، فوصل ابن زيدون مدينة إِشبيلية. وكان قد أسن، فمرض فيها ومات سنة 463 هـ / 1069 م. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]لابن زيدون ديوان شعر حافل بالقصائد المتنوعة، طبع غير مرة في القاهرة وبيروت وأهم ما يضمه قصائدة الغزلية المستوحاة من حبه لولادة، وهو غزل يمتاز بصدق العاطفة وعفوية التعبير وجمال التصوير، ومن بين تلك القصائد (النونية) المشهورة التي نسج اللاحقون على منوالها ومطلعها: [/FONT] [FONT=Arial (Arabic)]أضحى التنائي بديلاً من تنادينا ...... وناب عن طيب لقيانا تجافينا[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]ومن الأبيات الواردة في القصيدة:[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]يكاد حين تناجيكم ضمائرنا ...... يقضي علينا الأسى لولا تأسينا [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]حالت لفقدكم أيامنا فغدت ...... سوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]إن الزمان الذي ما زال يضحكنا ...... أنساً بقربكم قد عاد يبكينا [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]سران في خاطر الظلماء يكتمنا ...... حتى يكاد لسان الصبح يفشينا[/FONT] [FONT=Arial (Arabic)]وبعد فراره من السجن قصد مدينة الزهراء في إحدى ضواحي قرطبة وتأمل طبيعة افتقد جمالها في السجن، فتذكر ولادة ونظم قصيدة مطلعها: [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]إني ذكرتك بالزهراء مشتاقاً ...... والأفق طلق ومرأى الأرض قد راقا [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وفي ديوان ابن زيدون مدائح كثيرة في بني جمهور وبني عباد وفيه مطارحات بينه وبين ولادة ومساجلات بينه وبين المعتمد بن عباد. وأوصاف لمشاهد الطبيعة ورثاء واستعطاف وشكاوى كلها تحعل ابن زيدون من كبار شعراء الأندلس. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]أما نثره فلا يقل عن شعره قيمة فلم يصلنا منه سوى رسالتين تبينان قوة ملكته اللغوية وعمق ثقافته ولكن قلة انتاجه النثري جعل ابن زيدون في مصاف الشعراء وقلما يذكر بين الكتاب والمعروفين. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]أما الرسالتان النثريتان فالأولى منهما تهكمية وضعها على لسان ولادة ووجهها إلى ابن عبدوس غريمه في الحب وخصمه في السياسة وقد استرسل فيها وأطال وضمنها أخبار العرب وأشعارهم، وما استطاع لسانه السليط أن يوفر من نابي اللفظ الرسالة وقد اشتهرت رسالة ابن زيدون التهكمية وعدت مثالاً للبلاغة ونموذجاً للنقد المتهكم.. وفي مستهلها يقول ابن زيدون: [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)](أما بعد أيها المصاب بعقله، المورط بجهله البين سقطه، الفاحش غلطه العاثر في ذيل اغتراره، الأعمى عن شمس نهاره ... الساقط سقوط الذباب على الشراب، المتهافت تهافت الفراش في الشهاب، فإن العجب أكذب ومعرفة المرء نفسه أصوب ... ). [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]أما الثانية فهي الرسالة الجدية التي كتبها في سجنه إلى الأمير أبي الحزم بن جمهور يتنصل فيها من التهم الموجهة إليه ويستعطف أميره ويذكره بإخلاصه له، ويختمها بقصيدة تعد من أجمل ما نظم في الإستعطاف. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]وصفوة القول أن ابن زيدون هو علم من أعلام الأدب العربي. شعره ونثره وقد يصح فيه قول ابن بسام في كتابه (الذخيرة): (كان أبو الوليد خاتمة شعراء بني مخزوم وأحد من خبر الأيام خبراً ووسع البيان نظماً ونثراً ... )[/FONT]
=========================



[FONT=Arial (Arabic)]العقاد شاعر وكاتب مصري ، ولد بأسوان سنة 1889م وبعد أن أتم وظيفة كتابية لم يلبث أن تركها، اشتغل بالصحافة وأقبل على تثقيف نفسه ثقافة واسعة. [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]بدأ إنتاجه الشعري قبل الحرب العالمية الأولى وظهرت الطبعة الأولى من ديوانه سنة 1916م والطبعة الثانية سنة 1928م في أربعة أجزاء، وتوالت بعد ذلك مجموعاته الشعرية بعناوين مختلفة : (وحي الأربعين) و (هدية الكروان) و (عابر سبيل) ..[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]العقاد يعني بأصالة الشعور والفكر حتى حين كان ينظم في المناسبات، ويرى أن العناية بالصياغة وحدها لا تنتج شعراً له قيمة، وقد ارتاد للشعر العربي آفاقاً جديدة،فلم يكتف بالشعر القصصي، بل اتخذ من البيئة المصرية ومشاهد الحياة العادية مصادر للإلهام، ولتأكيد هذا المذهب خاض العقاد الناقد معارك شديدة مع أنصار القديم، تتمثل حدتها الأولى في كتاب اشترك فيه المازني، وصدر باسم (الديوان) سنة 1921م، [/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]عنى العقاد بابن الرومي، وكتب عنه كتاباً كبيراً وقد غلب فن المقالة على انتاج العقاد .. النثر الأول: (الفصول)، مطالعات في الكتب والحياة، (مراجعات الآداب والفنون)، ثم كتب سلسلة سير الأعلام في الإسلام بطريقة خاصة أشبه برسم الشخصيات: (عبقرية محمد) و (عبقرية عمر) وغيرهما، ورواية واحدة (سارة)، واتجه العقاد إلى الفلسفة والدين ومن مؤلفاته (الله) و (الفلسفة القرآنية)، و (ابليس) ..[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]في عنفوان نشاط الوفد المصري كان العقاد يكتب الافتتاحيات السياسية في جرائده، مثل (البلاغ) و (الجهاد) وكتب سيرة للزعيم سعد باشا زغلول سنة 1936م. وصدرت عن العقاد عدة بحوث أهمها للآن كتاب بقلم تلاميذه..[/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]توفي العقاد سنة 1964م عن خمسة وسبعين عاماً. [/FONT]
=========================
يتبع ....