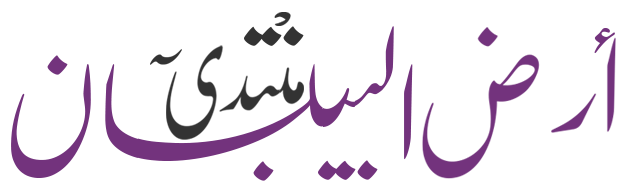The Hero

الأســــــــــــــطورة

- إنضم
- Jun 29, 2008
- المشاركات
- 20,104
- مستوى التفاعل
- 69
- المطرح
- في ضحكة عيون حبيبي
أولا ـ اللامات
اللام أحد حروف المعاني الدالة على معنى في غيره ، كبقية حروف المعاني الأخرى التي تعرضنا بالحديث عنها ، وكما بين ذلك نحاة العربية ، وقد ذكر بعض النحويين المحدثين أن اللام تكون حرفا من حروف المعاني التي تدل على معنى في غيرها إذا كانت محصورة في حرف الجر ، أما إذا كانت غير جارة كلام الجزم ، واللام غير العاملة فهي حرف من حروف المعاني الدالة على معنى في نفسها ، وقد شمل هذا التقسيم عند الباحث جميع حروف المعاني ، فما كان منها عاملا الجر ، جعله من الحروف الدالة على معنى في غيرها ، وما كان منها لغير الجر جعله من الحروف الدالة على معنى في نفسها ، وأرى في هذا التقسيم أيضا تشتيتا لذهن الدارس ، وقد ذكرنا رأينا في هذا الموضوع ولسنا في حاجة إلى معاودة الحديث فيه . وقد اعتمد الباحث في تقسيمه هذا على تعريف بعض الأصوليين للحرف باعتبار أن بعض معناها إيجادي ، والبعض الآخر معناه إحضاري ، ويقصد بالمعنى الإيجادي أن تلك الحروف وضعت لإيجاد نسبة ، أو علاقة بين الألفاظ حين استعمالها في الجملة ، فإذا قلنا : سرت من بغداد إلى الشام ، فإن حرف الجر " من " ، أو " إلى " لم يعط أي دلالة في نفسه سوى القيام بوظيفة الربط بين الفعل والاسم ، وإيجاد النسبة بينهما ، حيث إننا من خلال استعمال الحرفين السابقين استطعنا أن نفهم أن بغداد كانت نقطة البدء في السير ، وأن الشام كانت نقطة الانتهاء .
ويقرر الباحث على ضوء ما سبق أن الحروف الإيجادية لم توضع في اللغة لإيجاد معنى أصلا ، وإنما وضعت لتستعمل كأدوات ربط بين الألفاظ ليس غير .
أما الحروف ذات المعنى الإخطاري ، فهي الحروف الحاكية عن معنى مخطر في الذهن ، أي أن شأنها في الاستعمال شأن الأسماء ، والأفعال ، فكما أن الأسماء ، والأفعال عندما تستعمل تدل على المعنى المفهوم منها ، والمتقرر في الذهن ، أو الخاطر ، والحاضر في الذهن ، كذلك الحروف الإخطارية ، وتشمل الحروف الإخطارية جميع حروف المعاني التي لا تعمل الجر (1) .
أقسام اللام :
تنقسم اللام قسمين :
أ ـ اللام العاملة ، وتشمل لام الجر ، ولام النصب ، ولام الجزم ، وقد تعرضنا لتلك في أبوابها ، ولا داعي لتكرارها .
ب ـ اللام غير العاملة ، وتنقسم إلى أنواع متعددة ، وسنتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله .
أقسام اللام غير العاملة : ـ
1 ـ لام الابتداء : حكمها الفتح ، وتكون لتوكيد مضمون الجملة ، وتختص بالدخول على الأسماء الواقعة مبتدآت ، أو ما حل في موضعها من المضارع ، وتخليصه إلى الحال . مثال دخولها على الأسماء : لمحمدٌ أحق بالجائزة .
156 ـ ومنه قوله تعالى : { ولدار الآخرة خير }2 .
وقوله تعالى : { لأنتم أشد رهبة في صدورهم }3 .
ومنه قول زهير :
ولأنت أشجع حين تتجه الأبطــال من ليث أبي أجر
ومثال دخولها على الأفعال المضارعة : لَيقومُ أخوك ، ولَيدخلُ والدك .
كما تدخل على الفعل الجامد لمشابهته بالاسم ، كنعم ، وبئس .
59 ـ نحو قول زهير :
ولنعم حشو الدرع أنت إذا دُعِيتْ نزال ولُجَّ في الذُّعر
ــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ بتصرف عن كتاب اللامات للدكتور عبد الهادي الفضلي ص60 وما بعدها .
2 ـ 30 النحل . 3 ـ 13 الحشر .
157 ـ ومنه قوله تعالى : { لبئس ما كانوا يعملون }1 .
كما تدخل على الفعل الماضي المتصرف المقرون بقد .
نحو : إنك لقد فعلت خيرا .
وربما دخلت أيضا على بعض الحروف الناصبة للفعل كـ " أنْ " المصدرية ، لأنها تكون مع الفعل في موضع المبتدأ . نحو : لأن تقول الحق خير من أن تصمت .
وعلى " سوف " لأنها تخلص الفعل للاستقبال .
158 ـ نحو قوله تعالى : { ولسوف يعطيك ربك فترضى }2 .
2 ـ اللام المزحلقة : تدخل للام الابتداء السابقة الذكر في مواضع غير التي ذكرنا ، فهي تدخل على خبر المبتدأ ، ويكون ذلك قياسا إذا كان خبرا لـ " إنَّ " المكسورة الهمزة المشبهة بالفعل ( حرف توكيد ونصب ) .
نحو : إن محمدا لصادق .
159 ـ ومنه قوله تعالى : { إن الله لغفور رحيم } 3 .
وقوله تعالى : { إن ربك لسريع العقاب }4 .
وتدخل على خبر " إن " إذا كان فعلا مضارعا ، أو ظرفا ، أو جارا ومجرورا .
مثال دخولها على المضارع قوله تعالى : { إني ليحزنني أن تذهبوا به }5 .
60 ـ ومنه قول أبي صخر الهذلي :
إني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر
ومثال دخولها على الظرف : إن محمدا لعندك .
ومثال دخولها على المجرور قوله تعالى : { وإنك لعلى خلق عظيم }6 .
ــــــــــــــــــــ
1 ـ 62 المائدة . 2 ـ 5 الضحى .
3 ـ 18 النحل .4 ـ 167 الأعراف .
5 ـ 13 يوسف . 6 ـ 4 القلم .
وتسمى هذه اللام التي ذكرناها في المواضع السابقة باللام المزحلقة ، لأنها تزحلقت من اسم " إن " إلى خبرها .
وقد ذكر الرماني أن هذه اللام " كان حقها أن تكون قبل " إنَّ " إلا أنهم كرهوا الجمع بين حرفي التوكيد فزحلقوا اللام إلى الخبر ، وكانت اللام أولى بذلك لأنها غير عاملة ، فكان تقديم العامل أولى " (1) .
3 ـ اللام الزائدة :
1 ـ إذا دخلت لام الابتداء على خبر المبتدأ ، ولم يكن مصدرا بـ " إنَّ " فهي حينئذ زائدة ، لآن لام الابتداء لها الصدارة في الكلام .
نحو : لشاعر أنت .
61 ـ ومنه قول رؤبة بن العجاج :
أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة
وقد ذكر ابن هشام في المغني فقال : " اللام الزائدة وهي الداخلة في خبر المبتدأ ، واستشهد ببيت رؤبة السابق ، وقال : " وقيل الأصل لهي عجوز " .
2 ـ وكما تزاد اللام في خبر المبتدأ ، تزاد أيضا في خبر " أن " المفتوحة الهمزة ، كقراءة سعيد بن جبير في قوله تعالى : { ألا أنهم ليأكلون الطعام }2 .
62 ـ ومنه قول الشاعر ( بلا نسبة ) :
ألم تكن حلفت بالله العلي أن مطاياك لَمِن خير المطي
3 ـ وفي خبر لكنَّ . نحو : ولكن الأمر لشديد .
ومنه قول الشاعر ( بلا نسبة ) :
يلومونني في حب ليلى عواذلي ولكنني من حبها لعميد
4 ـ وفي خبر ما زال . نحو : ما زال المطر لمنهمرا .
ــــــــــــــــــ
1 ـ كتاب معاني الحروف ص51 .
2 ـ 20 لقمان .
ومنه قول كثير عزة :
وما زلت من ليلى لدن أن عرفتها كالهائم المقصي بكل مراد
5 ـ وفي المفعول الثاني لرأى . نحو : أراك لقادما .
6 ـ في خبر أمسى .
63 ـ كقول الشاعر :
مروا عجالا فقالوا كيف صاحبكم قال الذي سألوا : أمسى لمجهودا (1) .
7 ـ وقد تزاد مع " إنْ " الشرطية ، وهذا خاص بالشعر كما ذكر ابن هشام .
نحو : لئن قام زيد أقم ، وأنت ظالم لئن فعلت .
64 ـ ومنه قول الشاعر :
لئن كانت الدنيا عليَّ كما أرى تباريح من ليلى فللموت أروح
ومنه قول الآخر :
لئن كان ما حدثته اليوم صادقا أصُم في نهار القيظ للشمس باديا
8 ـ وتزاد مع الجار والمجرور للتوكيد .
كقول الشاعر ( بلا نسبة ) :
فلا والله لا يلقى لما بي ولا لِلِما بنا أبدا دواء
ومنه قول الآخر :
إن الخلافة بعدهم لذميمة وخلائقٌ ظرفٌ لِمِما أحقر
9 ـ وتزاد مع لولا للتوكيد أيضا كما في
قول الشاعر ( بلا نسبة ) :
للولا قاسم ويدا مسيلٍ لقد جرت عليك يد غشوم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ روي البيت السابق برواية أخرى هي :
مروا عجالى فقالوا كيف سيدكم فقال من سألوا : أمسى لمجهودا
راجع في ذلك كتابنا المستقصى في معاني الأدوات النحوية وإعرابها . اللام الزائدة .
ومنه قول الآخر ( بلا نسبة ) :
للولا حصينُ عُقْبةٍ أن أسوءه وأن بني سعد صديق ووالد
10 ـ وزيدت في " بَعْد " .
كقول الشاعر ( بلا نسبة ) :
ولو أن قومي لم يكونوا أعزة لَبَعْدُ لقد لاقيت لا بد مصرعا
وأغلب المواقع التي زيدت فيها اللام في الشواهد السابقة لا يقاس عليها ، وإنما يقتصر سماعها على الشعر .
* وتزاد لام البعد ، وكاف الخطاب في أسماء الإشارة ، يمكن الرجوع إليهما في موضعهما .
هذا وقد زيدت اللام زيادات صرفية في مواضع مختلفة من الكلمة ، وقد قسم النحويون زيادتها إلى قسمين :
زيادة لازمة ، وأخرى خير لازمة .
الزيادة اللازمة جاءت في ثلاثة مواضع هي : ـ
1 ـ أسماء الموصول . نحو : الذي ، والتي ، والذين ، وفروعها باعتبار أن الأسماء الموصولة معرفة بالصلة على المشهور ، لا باللام الاخلة عليها .
2 ـ بعض الأعلام : كـ للات ، والعزى ، والنضر ، والسموءل ، واليسع ، وغيرها من الأسماء التي لحقتها اللام . فاللام فيها زائدة ، لأن تلك الأسماء معرفة في ذاتها بالعلمية كغيرها من بقية الأعلام كمحمد ويوسف .
3 ـ " الآن " : ذكر ابن الناظم أن الألف ، واللام في كلمة " الآن " زائدة ، فقال : " ونحو الآن فإنه مبني لتضمنه معنى أداة التعريف ، والألف واللام فيه زائدة غير مفارقة " (1) .
ــــــــــــــــــــــــ
1 ـ شرح ابن الناظم ص100 ، ورصف المبني ص 164 .
أما الزائدة غير اللازمة ، وتسمى بالعارضة أيضا ، وتكون زيادتها في الآتي :
1 ـ المصادر ، والأعلام المنقولة المسمى بها على معنى لمح الصفة في أصل التسمية . كالحسن ، والحسين ، والفضل ، والرشيد ، والحارث ، والضحاك ، والمعتصم ، والأمين ، والمأمون ، وغيرها . فالمصادر ، والأسماء السابقة ، وما شابهها قد سمي بها مجردة من اللام ، ثم دخلت عليها اللام للإشارة إلى أصلها الذي نقلت عنه من وصف ، أو مصدر .
2 ـ اللام الزائدة زيادة غير لازمة في العدد وتمييزه . نحو : دفعت له الخمسة عشر الجنيهات .
3 ـ وقد زيدت أيضا زيادة غير لازمة في المسموع من الشعر للضرورة ، وجاءت هذه الزيادة في موضعين هما :
أ ـ الأعلام .
65 ـ كقول الشاعر :
ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيت عن بنات الأوبر
الشاهد قوله : بنات الأوبر ، وأراد بنات أوبر ، وكلمة أوبر علم لنوع من الكمأة .
ب ـ في التمييز الملحوظ .
66 ـ كقول الشاعر :
رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس من عمرو
الشاهد قوله : " طبت النفس " ، وأراد طبت نفسا . (1) .
4 ـ اللام الفارقة : هي اللام الواقعة بعد " إنْ " المخففة من الثقيلة .
نحو : إن محمدٌ لقائمٌ .
ـــــــــــــــــــــــــ
1 ـ للاستزادة في هذا الموضوع راجع كتابنا المستقصى في معاني الأدوات النحوية وإعرابها ج1 ،
وباب الموصول الحرفي لمعرفة مواطن زيادة أل مفصلة .
ومنه قوله تعالى : { وإن كانت لكبيرة }1 .
160 ـ وقوله تعالى : { إن كل نفس لما عليها حافظ }2 .
وهذه اللام نوع من " لام " الابتداء ، فقد ذكر سيبويه ، وأكثر النحاة أنها لام الابتداء أفادت مع إفادتها توكيد النسبة ، وتخليص المضارع للحال ، الفرق بين " إنْ " المخففة من الثقيلة ، و " إنْ " النافية ، لهذا صارت لازمة بعد أن كانت جائزة ، اللهم إن دل دليل على قصد الإثبات " (3) .
كقراءة أبي رجاء في قوله تعالى : { وإن كل ذلك لِما متاع الحياة الدنيا }4 .
بكسر اللام ، أي : للذي .
5 ـ اللام الوطئة للقسم : وتسمى اللام المؤذنة ، وهي التي تمهد لجواب القسم ، وتدخل عل أداة الشرط ، للئيذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها ، لا على شرط . 161 ـ كقوله تعالى : { لئن أمرتهم ليخرجن }5 .
وقوله تعالى : { لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون }6 .
وغالبا ما يكون دخول اللام الموطئة للقسم على " إن " الشرطية ، ولكن سيبويه ذكر أن دخولها لا يقتصر على إن الشرطية ، بل تدخل أيضا على " ما " الموصولة ، 162 ـ كقوله تعالى : { وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لَمَا آتيتكم من كتاب وحكمة }7.
وقال سيبويه : " والله لئن فعلت لأفعلن ، واللام التي في " ما " كهذه التي في " إن " .
ــــــــــــــــــــ
1 ـ 143 البقرة . 2 ـ 4 الطارق .
3 ـ المغني ج1 ص 231 وما بعدها .
4 ـ 143 البقرة . 5 ـ 4 الطارق .
6 ـ 12 الحشر . 7 ـ 81 آل عمران .
وبالرجوع إلى كتب التفسير نجد أن " ما " في الآية السابقة شرطية ، والمعنى لمهما آتيتكم ، وعليه فاللام الداخلة عليها تكون موطئة للقسم ، تشبيها لـ " ما " الشرطية ، بـ " إن " الشرطية ، واللام كـ " اللام " الداخلة على " إن " ، ولكن لشذوذ دخول اللام الموطئة للقسم على غير " إن " الشرطية ، فتكون " ما " موصولة ، واللام للابتداء حملا على الأكثر (1) .
وقد دخلت " اللام " الموطئة للقسم على " إذ " لمشابهتها " إن " الشرطية .
67 ـ كما في قول الشاعر ( بلا نسبة ) :
غضبتْ عليَّ وقد شربت بجِزَّة فلإذ غضبتِ لأشربنْ بخروف
ودخلت أيضا على " متى " .
68 ـ كقول الشاعر ( بلا نسبة ) :
لمتى صلحت ليقضين لك صالح ولتجزينَّ إذا جزيتَ جميلا
تنبيه : إن دخول اللام فيما سبق على غير " إنْ " الشرطية لا ينقاس عليه .
6 ـ اللام الواقعة في جواب القسم :
لام تدخل على الجمل الاسمية ، والفعلية ، الواقعة جوابا لقسم ظاهر .
نحو : أقسم بالله لخالد قادم ، وأقسم بالله لأقولن الحق .
163 ـ ومنه قوله تعالى : { تالله لقد آترك الله }2 .
وقوله تعالى : { وتالله لكيدن أصنامكم }3 .
ويكثر في الفعل الماضي المتصرف إذا وقع جوابا للقسم أن يقترن بـ " قد " .
نحو قوله تعالى : { تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض }4 .
وقوله تعالى : { تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك }5 .
ـــــــــــــــــــ
1 ـ المغني ج1 ص 235 .
2 ـ 91 يوسف . 3 ـ 57 الأنبياء .
4 ـ 73 يوسف .5 ـ 63 النحل .
وقد لا يقترن بها كما في قول امرئ القيس :
حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما من حديث ولا صالي
وقد تلحق اللام جواب القسم المحذوف ، ولم يبق منه إلا المقسم به كما في الآيتين السابقتين ، وقد تلحق جواب القسم المحذوف بالكلية .
نحو : لقد قدمتك على المتفوقين .
164 ـ ومنه قوله تعالى : { لقد من الله على المؤمنين }1 .
وقوله تعالى : { لقد نصركم الله في مواطن كثيرة }2 .
7 ـ اللام الواقعة في جواب لو ، ولولا :
كقوله تعالى : ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم }3 .
وقوله تعالى : { لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا }4 .
69 ـ ومنه قول الحمير :
ولو أن ليلى الأخيلية سلمــت علىَّ ودوني جنــدل وصفائـح
لسلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر صائح
ومثال اللام الواقعة في جواب لولا .
قوله تعالى : { لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض }5 .
ومنه قول المتنبي :
ولولا أنني في غير نوم لكنت أظنني مني خيالا
8 ـ لام البعد : هي اللام الداخلة على أسماء الإشارة للدلالة على البعد ، وتعد من أنواع اللامات الزائدة .
165 ـ نحو قوله تعالى : { ذلك الكتاب لا ريب فيه }6 .
ـــــــــــــــ
1 ـ 164 آل عمران . 2 ـ 25 التوبة .
3 ـ 66 النساء . 4 ـ 22 الأنبياء .
5 ـ 251 البقرة . 6 ـ 1 البقرة .
وقوله تعالى : { تلك آيات الكتاب المبين }1 .
9 ـ لام التعجب غير الجارة : يقول عنها ابن هشام ، وقد ذكر ذلك ابن خالويه في كتابه المسمى بالجمل " وعندي أنها لام الابتداء دخلت على الفعل الماضي لشبهه في جموده بالاسم ، وإما لام جواب قسم مقدر " (2) .
نحو : لَظَرُف زيد ولَكَرُم عمر . بمعنى ما أظرفه ، وما أكرمه .
10 ـ لام " أل " التعريف : وهي اللام الداخلة على الأسماء راجعها في بابها .
ثانيا ـ حرفا الخطاب : الكاف ، والتاء
أولا ـ الكاف : حرف خطاب مبني لا محل له من الإعراب ، ويكون في المواضع التالية :
1 ـ اسم الإشارة . نقول : ذلك ، وتلك ، وذاك .
166 ـ ومنه قوله تعالى : { ذلك الدين القيم }3.
2 ـ آخر ضمير النصب المنفصل " إياك " وأخواته . لأن " إيا " هو الضمير ، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب .
167 ـ نحو قوله تعالى : { إياك نعبد وإياك نستعين }4 .
3 ـ بعد الضمير الواقع في الفعل " أرأيت " الذي بمعنى " أخبرني " .
168 ـ نحو قوله تعالى : { أرأيتك هذا الذي كرمت عليَّ }5 .
4 ـ آخر بعض الأفعال ، وأسماء الأفعال :
نحو : أبصرك محمدا . وليسك الرجل قائما . ونعمك الطالب عمرو .
وبئسك المهمل فيصل .
ومثال اتصالها بأسماء الأفعال : حيهلك ، ورويدك ، والنجاءك .
فالكاف في الأفعال السابقة ، وأسمائها حرف خطاب مبني لا محل له من الإعراب .
ــــــــــــــــــــــ
1 ـ 2 القصص . 2 ـ المغني ج1 ص 237 .
3 ـ 40 يوسف . 4 ـ 4 الفاتحة .
5 ـ 62 الإسراء .
5 ـ كما تتصل ببعض الحروف وهي : بلا ، وكلا .
نحو : بلاك ، وكلاك .
وهذا النوع الأخير لا ينقاس عليه ، وإنما ذكرناه للفائدة .
تنبيه :
لقد ورد ذكر " الكاف " في حروف الجر ، وقد ورد كحرف خطاب ، وورد ضميرا في محل نصب ، ثم عددوا لها مواضع إعرابية كثيرة ، وفي جميع هذه المواضع تكون مضافة إلى ضميرا منفصلا ، ونذكر هنا وروده اسما بمعنى " مثل " وتفيد التشبيه .
فقد أثبت النحويون مجيء " الكاف " بمعنى " مثل " كغيرها من الأدوات الدائرة بين الحرفية ، والاسمية ، وقد تعرضنا لهذا الموضوع في باب حروف الجر .
وإليك مواضعها الإعرابية مفصلة :
1 ـ تأتي فاعلا .
70 ـ كقول الأعشى :
أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل
الشاهد قوله : " كالطعن " فالكاف في محل رفع فاعل ، وهي مضاف ، والطعن مضاف إليه .
2 ـ تأتي " الكاف " في محل رفع مبتدأ .
71 ـ كقول أوس بن حجر :
أبدا كالفراء فوق ذراها حين يطوي المسامع الصدار
ومنه قول المتنبي :
أتت زائرا ما خامر الطيب ثوبها كالمسك من أردانها يتضوع
الشاهد في البيتين السابقين قول الأول : " كالفراء " ، وقول الثاني : " كالمسك " ، فالكاف في كل من الكلمتين في محل رفع مبتدأ ، والفراء ، والمسك في محل جر مضاف إليه .
3 ـ تأتي في محل رفع اسم كان .
72 ـ كقول جميل بثينة :
لو كان في قلبي كقدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي
الشاهد قوله : " كقدر " ، فالكاف في محل رفع اسم كان ، وقد مضاف إليه .
4 ـ في محل نصب خبر كان .
73 ـ كقول الفرزدق :
وكنت كفاقئ عينيه عمدا فأصبح ما يضيء له نهار
الشاهد قوله : " كفاقئ " ، فالكاف في محل نصب خبر كان ، وفاقئ مضاف إليه .
5 ـ تأتي مفعولا به .
74 ـ كقول النابغة الذبياني :
لا يبرمون إذا ما الأفق جلله برد الشتاء من الأمحال كالأدم
الشاهد قوله : " كالأدم " فالكاف في محل نصب مفعول به لـ " يبرمون " .
6 ـ وتأتي خبرا لـ " إن " .
كقول مسكين الدارمي :
أخاك أخاك إنَّ من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح
فالكاف في " كساع " في محل رفع خبر إن ، وساع في محل جر بالإضافة .
7 ـ وتأتي مجرورة بحر الجر .
76 ـ كقول الشاعر ( بلا نسبة ) :
بكاللقوة الشعواء جلت فلم أكن لأولع إلا بالكمي المقنع
الكاف في قوله " بكاللقوة " في محل جر بالباء ، وهي مضاف ، واللقوة مضاف إليه .
8 ـ وتأتي في محل جر مضافا إليه .
77 ـ كقول الشاعر ( بلا نسبة ) :
تيم القلبَ حبُ كالبدر لا بل فاق حسنا من تيم القلب حبا
الكاف في قوله " كالبدر " في محل جر مضاف إليه للحب ، وهي مضاف ، والبدر مضاف إليه .
9 ـ تأتي صفة .
78 ـ كقول امرئ القيس :
وليل كموج البحر أرخى سدوله عليَّ بأنواع الهموم ليبتلي
الشاهد قوله : " كموج " فالكاف في محل جر صفة لليل ، وهي مضاف ، وليل مضاف إليه .
10 ـ وتأتي الكاف بمعنى " مثل " نائبة عن المفعول المطلق ، أو صفة لمفعول مطلق محذوف .
79 ـ كقول جرير :
من سد مطلع النفاق عليكم أم من يصول كصولة الحجاج
الكاف في قوله : " كصولة " إما نائبة عن المفعول المطلق ، والتقدير : يصول صولا مثل صولة الحجاج ، فحذف المفعول المطلق ، وأناب عنه نائبه ، أو هي صفة له (1) .
ثانيا ـ التاء : ذكرنا في باب الضمائر أن الكاف ، والتاء إذا اتصلتا بالفعل ، أو اتصلت إحداها به كانت ضميرا متصلا للمخاطب .
نحو : أكرمتك ، وأكرمت محمدا ، وأكرمك عليٌّ .
ثم ذكرنا أن التاء ، والكاف حرفا خطاب ، أما الكاف ففصلنا فيها القول أنفا ، وأما التاء فهي حرف خطاب إذا لحقت الضمير المنفصل المرفوع .
نحو : أنت كريم ، وأنتِ مهذبة .
فالتاء في " أنتَ " ، و " أنتِ " حرف خطاب ، و" أن " هو الضمير ، وهذا مذهب
ـــــــــــــــــــــ
1 ـ المستقصى في معاني الأدوات النحوية وإعرابها ج 2 .
جمهور النحاة . أما بعض النحويين كالفراء يرى أن مجموع الكلمة " أنت " هو الضمير (1) .
وكذلك الحال في " أنتما ، وأنتم ، وأنتن " ، فـ " أن " هو الضمير ، والتاء حرف خطاب ، والميم زائدة للدلالة على التثنية في أنتما ، وعلى الجمع في أنتم ، والنون في أنتن حرف زائد للدلالة على النسوة .
ثالثا ـ حرف الإنكار : حرف من حروف المد ، كالزيادة اللاحقة للندبة ، ويأتي على معنيين :
1 ـ أن تنكر وجود ما ذكر وجوده ، وتبطله ، كرجل قال : أتاك زيد ، وزيد ممتنع أتيانه فينكر لبطلانه عنده .
2 ـ أن تنكر أن يكون على خلاف ما ذكر . كقولك : أتاك زيد ، فتنكر سؤاله عن ذلك ، وزيد من عادته أن يأتيه .
ومن أمثلة ماسبق أن نقول : أزيدنيه . دون أن نفصل بين الاسم وبين حرف الإنكار بفاصل . ومن العرب من يفصل بين الاسم وحرف الإنكار بفاصل .
نحو قولهم : أزيدانيه . فقد زيدت " إن " بين حرف المد ، وبين الحرف الأخير من الاسم .
ويتبع حرف الإنكار حركة الحرف الأخير من الاسم الذي يلحقه ، فإذا كانت حركة الحرف الأخير من الاسم مضمومة ، ولم يفصل بينه وبين حرف الإنكار بفاصل كانت الزيادة واوا . نحو : قولهم : في جواب من قال : هذا عمر منكرا إياه " أعمروه " .
وإن كان مفتوحا كانت الزيادة ألفا . نحو قولهم : في جواب من قال : رأيت سلمان " أسلماناه " . ــــــــــــــــــــــــ
2 ـ الجنى الداني ص 58 ، ورصف المباني ص 245 ،
وشرح المفصل لابن يعش ج 7 ص 126 .
وإن كان مكسورا كانت الزيادة ياء . نحو قولهم : في جواب من قال : مررت بحذام : أحذاميه .
وكل ما سبق شبيه بزيادة الندبه ، كما هو الحال في الاسم المندوب .
أما إذا كان الحرف الأخير من الاسم ساكنا قدرت الزيادة ساكنة ، ثم كسر الساكن الأول لالتقاء الساكنين ، وجعلت ما قبل الزيادة ياء من جني الكسرة .
نحو : قولك في جواب من قال : هذا زيدا : أزيدنيه ، فالدال مضمومة محكية ، وحركتها إعراب ، والتنوين متحرك بالكسر ، وحركتها بناء لالتقاء الساكنين (1) .
ويكون حرف الإنكار في آخر الكلام ومنتهاه ، لذلك يقع بعد المعطوف .
نحو : قولك : مجيبا لمن قال : لقيت زيدا وعمرا : أزيدا وعمرنيه .
فقد أسقط حرف الإنكار من المعطوف عليه ، ولحق المعطوف ، لأنه آخر الكلام ، مع كسر التنوين لسكون المد بعده ، وتجعل حرف الإنكار " ياء " لانكسار ما قبله .
ويقع بعد الضمة . نحو : أزيدا الطويلاه ، جوابا لمن قال : ضربت زيدا الطويل .
ويقع بعد المفعول به . نحو : أضربت عمراه . جوابا لمن قال : ضربت عمر .
ومن الأمثلة السابقة يتضح أن حرف الإنكار ( حرف المد ) لا يلحق إلا آخر الكلام ، فإذا كان آخر الكلام صفة لحقها ، ولم يلحق الموصوف ، وإذا كان معطوفا لحقه ، ولم يلحق المعطوف عليه ، وكذلك إذا كان أخر الكلام مفعولا به لحقه ولم يلحق الفاعل ولو كان اسما ظاهرا .
رابعا ـ تاء التأنيث الساكنة :
حرف يختص بالدخول على الفعل الماضي لفظا ، سواء أكان في المعنى مستقبلا ، أم لم يكن ، فتدل على تأنيث فاعله ، إما حقيقة ، أة مجازا .
مثال دخولها على الماضي مع عدم دلالته على المستقبل ، والفاعل مؤنثا حقيقيا : قامت فاطمة .
ـــــــــــــــــــ
1 ـ شرح المفصل ج 9 ص 51 .
169 ـ ومنه قوله تعالى : { إذ قالت امرأة عمران }1 .
ومثال الفاعل المؤنث مجازيا : طلعت الشمس .
ومثال دخولها على الفعل الماضي الدال على المستقبل : إن قامت هند قمت .
ومتى طلعت الشمس يحل الدفء .
ومنه قوله تعالى : { علمت نفس ما قدمت }2 .
* وتاء التأنيث الساكنة حرف بالإجماع سواء تقدمت على الاسم المؤنث ، نحو : نجحت مريم . أو تأخرت عنه ، نحو : عائشة وصلت .
والدليل على حرفيتها عند تأخيرها عن الاسم بروز ضمير التثنية " الألف " معها فنقول : الطالبتان قامتا . ولو كانت ضميرا لما اجتمعت مع ضمير ألف الاثنين .
* ولا تكون تاء التأنيث إلا ساكنة وصلا ، ووقفا . نحو : قامت هند ، وسعاد جلست . إلا إذا تلاها ساكن حركت بالكسر لالتقاء الساكنين . نحو : قامت المرأة .
كما تحرك بالفتح إذا لحقها ألف الاثنين . نحو : المرأتان قامتا .
* وحركتا الكسر ، والفتح في تاء التأنيث ليسا أصلا ، وإنما حركتان عارضتان ، الأولى : أوجدها التقاء الساكنين ، والثانية : أوجدها ضمير ألف الاثنين ، والأصل التسكين .
* وإذا لحقت تاء التأنيث الاسم ، فلا تكون ساكنة ، بل تكون متحركة في آخر الاسم أبدا ، وتأتي لمعان كثيرة ، نذكر منها ما يعود بالفائدة .
1 ـ للتفريق بين الاسم المذكر ، والمؤنث . نحو : جاء امرؤ ، وجاءت امرأة .
أو للتفريق الصفات المذكرة ، والمؤنثة . نحو : هذا مهندس ، وهذه مهندسة .
أو للتفريق بين المفرد واسم الجمع . نحو : هذه وردة ، وهذا ورد . وهذه تمرة ، وهذا تمر ، وهذه كمأة ، وهذا كمء .
ــــــــــــــــــــــ
1 ـ 135 آل عمران . 2 ـ 82 المائدة .
وللتفريق بين المفرد والجمع . نحو : رجل جوال ، ورجال جوالة ، وهذا بقّال ، وهؤلاء بقّالة .
2 ـ تأتي لتوكيد الصفة بغرض المبالغة . نحو : نسابة ، للعالم بالنسب .
وعلاّ للعالم بالعلوم المختلفة .
3 ـ تأتي للنسب مفردا . نحو : ثعالبة ، في المنسوبين إلى ثعلب . ومهالبة في المنسوبين إلى مهلب . وتغالبة في المنسوبين إلى تغلب ، فهي في معنى الثعلبيين ، والمهلبيين ، والتغلبيين .
4 ـ وتأتي لتأنيث اللفظ فقط اسما ، أو حرفا ويعرف بالتأنيث اللفظي . نحو : غرفة ، وبسطة .
ونحو : ثُمت ، ورُبت ، وثَمت ، ولعلت .
5 ـ وتأتي لتحديد اسم المرة ، واسم الهيئة . نحو : جلدته جلدة .
ونحو : جلست جلسة الأمير .
خامسا ـ نون التوكيد :
حرف إما أن يكون ثقيلا " مشددا " ، أو خفيفا ساكنا ، يختص بالدخول على الأفعال بشروط ، ويكون مبنيا لا محل له من الإعراب .
والنون الثقيلة أشد توكيدا للفعل من الخفيفة ، لتكرار النون فيها ، ويبنى الفعل معها على الفتح ، مع توكيده . نحو : تالله لأساعدن الضعيف .
170 ـ ومنه قوله تعالى : { ليسجننَّ وليكوننْ من الصاغرين}1 .
* حكم توكيد الأفعال بالنون وشروطها : ـ
أولا ـ الفعل الماضي :
يمتنع توكيده بالنون مطلقا ، لأنه لا يدل على طلب .
نقول : جاء الرجل راكبا ، ونام الطفل مبكرا . ولا يصح أن نقول : جاءنَّ الرجل ، ولا نامنْ الطفل .
ـــــــــــــــ
1 ـ 32 يوسف .
وما ورد منه مؤكدا فلدلالته على الاستقبال في المعنى .
80 ـ كقول الشاعر :
دامنَّ سعدك إن رحمت متيما لولاك لم يكُ للصبابة جانحا
ومنه ما ورد في الحديث عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم :
" فإمّا أدركنَّ واحد منكم الدجال " .
الشاهد في البيت قوله : " دامنَّ " ، وفي الحديث قوله : " أدركنَّ " ، وكلاهما فعلان ماضيان جاءا مؤكدان بالنون الثقيلة على غير القياس ، والمسوغ لتوكيد الفعل الأول مجيئه مستقبل المعنى ، لأنه يدل على الدعاء ، ومسوغه في الفعل الثاني مجيئه مستقبل المعنى أيضا ، لأنه فعل شرط . والله أعلم .
ثانيا ـ الفعل الأمر :
جائز التوكيد بالنون إذا استدعى الحال ذلك .
تقول : احفظن الدرس ، واجلسن مؤدبا ، واصبرن على أذى الجار .
وتقول : احفظ الدرس ، واجلس مؤدبا ، واصبر على أذى الجار .
81 ـ ومنه قول الشاعر :
فيا صاحبي إمّا عرضت فبلغن بني مازن والريب إلا تلاقيا
ثالثا ـ الفعل المضارع :
وفي توكيده ثلاثة أحوال : ـ
1 ـ يجب توكيده بالنون ثقيلة ، أو خفيفة بالشروط الآتية :
أ ـ أن يكون جوابا للقسم متصلا بلامه ، غير مفصول عنها بفاصل .
ب ـ أن يكون مثبتا مستقبلا .
ج ـ إلا يتقدم معموله عليه .
نحو : تالله لأكافئنَّ المجتهد .
171 ـ ومنه قوله تعالى : { تالله لأكيدن أصنامكم }1 .
وقوله تعالى : { لنتصدقن ولنكونن من الصالحين }2 .
ومنه قول الشاعر :
لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فما انقادت الآمال إلا لصابر
2 ـ يجوز توكيده بالشروط الآتية :
أ ـ إذا كان مستقبلا .
ب ـ أن يكون مسبوقا بأداة من أدوات الطلب ، وهي :
1 ـ لام الأمر . نحو : ليقولن الحق أو ليصمت ، ويجوز : ليول الحق .
2 ـ لا الناهية . نحو : لا تهملن الواجب .
ومنه قوله تعالى : { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله }3 .
172 ـ وقوله تعالى : { لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد }4 .
ومنه قول الشاعر :
لا تمدحن امرأ حتى تجربه ولا تذمنه من غير تجريب
ونقول : لا تهمل ، ولا تقول ، ولا يغرك ، ولا تمدح .
3 ـ الاستفهام . نحو : هل تفوزن بالجائزة .
ومنه قوله تعالى : { هل يذهبن كيده ما يغيظ}5 .
ومنه قول الشاعر :
يا بنت عمي كتاب الله أخرجنى طوعا وهل أمنعن الله ما فعلا
82 ـ وقول الآخر :
ويا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذن لسعيد
ــــــــــــــــــــــ
1 ـ 57 الأنبياء . 2 ـ 75 التوبة .
3 ـ 23 الكهف .
4 ـ 196 آل عمران . 5 ـ 15 الحج .
وقول الشاعر :
أتهجرن خليلا صان عهدكم وأخلص الود في سر وإعلان
4 ـ التمني . نحو : ليتك تصغينَّ لنصيحتي .
83 ـ ومنه قول الشاعر :
فليتك يوم الملتقى ترينني لكي تعلمي أني امرؤ بك هائم
5 ـ الترجي . نحو : لعلك تصيبن خيرا .
6 ـ العرض : وهو الطلب بلين . نحو : ألا تساعدن المحتاج .
7 ـ الحض ، أو التحضيض : وهو الطلب بعنف وشدة . نحو : هلاَّ تقولن الحق .
84 ـ ومنه قول الشاعر :
هلاَّ تمنِّنْ بوعد غير مخلفة كما عهدتك في أيام ذي سلم
ويجوز في الأفعال السابقة عدم التوكيد كما بينا في أول الأمثلة .
ج ـ ويجوز توكيده أيضا إذا وقع الفعل بعد " لا " النافية .
نحو : أحب النشاط ولا أقبلنَّ الكسل .
173 ـ ومنه قوله تعالى : { فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها }1 .
ومنه قول الشاعر :
فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل
د ـ بعد إمَّا الشرطية .
174 ـ نحو : قوله تعالى : { إمَّا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله }2 .
وقوله تعالى : { وإمَّا تعرضنَّ عنهم ابتغاء رحمة من ربك }3 .
ومنه قول الشاعر :
فإما ترينني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها
ــــــــــــــــ
1 ـ 16 طه . 2 ـ 200 الأعراف .
3 ـ 28 الإسراء .