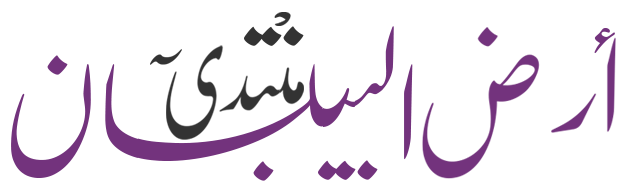دموع الورد

رئيس وزارء البيلسان



- إنضم
- Dec 19, 2009
- المشاركات
- 13,384
- مستوى التفاعل
- 139
- المطرح
- هنْآگ حيثّ تقيأت موُآجعيّ بألوُآنْ آلطيفّ..
السجع أهم خصائص النثر العربي الجوهرية. وقد يغني وجوده عن باقي المكونات الأخرى التي قد تدعمه وتليه في الأهمية. فيكون مجموع عناصر التناسب النثرية الضرورية أربعة، وهي:
السجع
التجنيس، أو ( الجناس )
الموازنة
الازدواج
وهذه المكونات الأربعة إذا اجتمعت كلها، وكان السجع قائدها تحقق التناسب الكامل والتناغم العالي الرفيع بين أجزاء الكلام المنثور: الكبرى والوسطى والصغرى؛ ونقصد بالأجزاء الكبرى نظام الفقرات، وبالوسطى نظام الجمل والفواصل، وبالصغرى نظام الكلمات والحروف.
وقد حرص النقاد والبلاغيون في تعريفهم وتحديدهم لعناصر بلاغة النثر الرباعية تلك أي: ( السجع، التجنيس، الموازنة، الازدواج ) على تأكيد خاصية التناسب اللفظي والصوتي التي تتكامل وتتقوى بتعاونها، بحيث ينهض كل عنصر بقدر معين معلوم منها. وكأنه أحد عناصر العزف والإيقاع الموسيقي المنسجم المتناغم داخل الجوقة الموسيقية الواحدة، مهما اختلفت في تنوع مصادر إيقاعها، وفي طبقاتها الصوتية التي تعلو وتنخفض تارة، وتقوى وتضعف تارة أخرى.
أ ـ تعريف السجع:
( يكون الكلام مسجوعا بتواطؤ الفواصل النثرية على حرف واحد ). وهذا أقصر التعريفات التي تطالعنا في بعض كتب ضياء الدين بن الأثير الجزري ك( المثل السائر)، ج1/ ص333، و( الجامع الكبير)، ص 251. وابن الأثير أحد وجوه النقد والكتابة العربية في العصر الأيوبي، توفي سنة 637 هجرية.
والمراد بالتواطؤ هنا: التتابع المنتظم للسجعات من غير نقص وتقطع أو إخلال ونبو، ومن غير تغيير لحركاتها وسكناتها، كما في قوافي الشعر المتحدة الصافية عندما تخلو من عيوب القوافي البشعة المرذولة كالإيطاء والتضمين وغير ذلك، مما هو مقرر وثابت بالشواهد والأمثلة في كتب العروض والتقفية.
فنظام السجع في النثر إذن، له صلة كبيرة بنظام القوافي الشعرية، كما سنوضح لاحقا، عند حديثنا عن ضرورات السجع ومحظوراته التي لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها في الشعر.
وقد دافع ابن الأثير عن السجع دفاعا مستميتا، وانحاز إليه كثيرا في كتاباته النثرية الإنشائية التي ملأ بها كتبه النقدية والبلاغية، ورسائله الديوانية والخاصة. وهذا رغم اعتراضات المعترضين الكثيرة على ظاهرة السجع؛ بسبب ما شابها من وهم وخلط، وخاصة عند من التبس عليهم الأمر، وخلطوا بين نهي الرسول الكريم لبعض صحابته عن استعمال ( السجع النوعي ) أي: ( سجع الكهان) وبين ( السجع الفني ) كمصطلح بلاغي وظاهرة فنية صرفة.
أما سجع الكهان، فباعتباره نوعا نثريا قديما كان معروفا لدى العرب في نثرهم الجاهلي القديم. وكان مخصوصا بأهل الكهانة والعرافة ومحصورا في بيئتهم. وقد كان لخاصة الجاهليين وعامتهم، كما هو معروف، اعتقاد كبير في كلام الكهان المسجوع. وكانوا يخبرون به عن الغيبيات، تحت الطلب، ويدلسون بواسطته على الناس، فيما يشبه السحر والرموز المطلسمة.
وقد جـُبَّ هذا النوع بالإسلام لما فيه من ضلال وشرك، وخروج عن منهج التوحيد الإسلامي.
أما السجع الفني، فباعتباره حلية بلاغية جمالية مطلوبة، وظاهرة فنية خالصة مرغوبة، ولا يمكن أن تـُجَب أو تُحصر في زمان أو مكان.
وأمثلة السجع التطبيقية أكثر من أن تعد أو تحصى، وهي حاضرة بقوة في القرآن الكريم، بمستويات مختلفة، وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الخطب البليغة المحبرة، وفي الأمثال والأقوال المأثورة، وفي سائر النثر الإنشائي والتأليفي. بحيث إننا لا نبالغ إذا قلنا: إن السجع الفني يمثل الميزة الغالبة على الأساليب النثرية الرفيعة التي أشاعتها بلاغة الخطباء والمتحدثين الفصحاء، ورسختها أقلام كبار الكتاب والمنشئين.
ب ـ تعريف التجنيس، أو الجناس:
ذهب النقاد والبلاغيون في تعريف التجنيس وتقسيمه مذاهب شتى، ووضع بعضهم فيه كتبا مستقلة؛ ككتاب خليل بن أيبك الصفدي المشهور( جنان الجناس )، وقد أتى فيه على ما يقارب الستين قسما.
ومن التعاريف المختزلة للتجنيس: ( أن يكون تركيب الألفاظ في الكلام من جنس واحد ). ( المثل السائر)، ج1/ ص 142 و (الجامع الكبير)، ص 256.
والتجنيس في عرف البلاغيين اتحاد ( شكلي) كلي أو جزئي بين لفظتين أو أكثر داخل سياق الكلام؛ إما من جهة خط الحروف، أو من جهة شكلها وحركتها، أو من جهة نقطها أو إهمالها، مع اختلاف ( نوعي) في المعنى، كما في قوله تعالى: ( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة)، سورة الروم، الآية: 55. فمعنى ( الساعة ) الأولى يوم القيامة الموعود، ومعنى ( الــ ساعة ) الثانية: قدر الزمن الأرضي المعلوم.
ج ـ تعريف الموازنة:
الموازنة في النثر غير الوزن في الشعر، وهي هنا أقرب ما تكون إلى مفهوم الميزان الصرفي الذي يدرس أصول اشتقاق الكلمات العربية، ويضبط أوزانها القياسية والسماعية عند تحويلها من صيغها المصدرية إلى صيغها الفعلية.
فالموازنة في النثر تعني: توالي المفردات داخل الجمل والفواصل النثرية على نفس الميزان الصرفي، مما يتولد عنه تماثل في الحركات الإيقاعية وانتظام في المسافات الصوتية.
وقد دافع ابن الأثير أيضا عن خاصية الموازنة هذه، واعتبرها أساس الاعتدال في الكلام المنثور، قال في تعريف الموازنة وشرح خصائصها: ( الموازنة أن تكون ألفاظ الفواصل من الكلام المنثور متساوية في الوزن ، وللكلام بذلك طلاوة ورونق سببه الاعتدال، لأنه مطلوب في جميع الأشياء، وإذا كانت مقاطع الكلام معتدلة وقعت من النفس موقع الاستحسان). ( المثل السائر )،ج1/ ص 377.
والذي قصده ابن الأثير من الوزن هنا: الوزن الصرفي لا الوزن العروضي.
د ـ تعريف الازدواج:
ويكون الكلام مزدوجا ( إذا قسم إلى فقر متساوية ومتوازية في الطول أو القصر ). ( سر الفصاحة )، ص 165. وبعبارة أخرى أوضح أن يكون عدد الكلمات في الجملة النثرية الأولى مماثلا للعدد الموجود في الجملة الثانية، أولسائر الجمل المتتالية.
ولا ينبغي هنا أن تـَقصُر الفقرةُ أو الجملة النثرية الواحدة عن الأخرى كثيرا أو تطول عنها بقدر كبير، لكي يتحقق التناسب بصورة أكمل وأوضح، و( لئلا يبعد على السامع وجود القافية فتذهب اللذة) كما جاء في كتاب ( ثمرات الأوراق ) لابن حجة الحموي، ص 412.
وليس هناك حد ثابت لطول الجمل النثرية، خاصة إذا تداخلت في الجملة الكبرى الرئيسية جمل صغرى ثانوية. أما حد قِصرها فثابت ومعلوم؛ فأقصر ما تكون العبارة النثرية أن تتركب من كلمتين اثنتين، ولا يمكن أن تكون أقل من ذلك.
وكلما كانت العبارات النثرية قصيرة كلما اتضحت عناصر التناسب أكثر للسمع والبصر، وكان وقعها عليهما أكبر. وكلما طالت العبارات النثرية تبددت وحدتها وتشوهت ملامحها وضعف تأثيرها، وأشبهت الحديث اليومي العادي الذي يخلو، في الغالب، من التناسب والتنسيق إلا ما جاء عفو الخاطر.
ومما ينبغي الإشارة إليه أن وراء هذه التحديدات الأربعة البسيطة الرئيسية تفريعات تتعدد وتختلف باختلاف النقاد والبلاغيين في الزمان والمكان؛ فكثيرا ما مزج أصحاب البلاغة والبديع الأواخر بين تعريفهم لهذه العناصر البسيطة وتقسيمهم لها تقسيما جزئيا دقيقا، على عادتهم في تكثير المصطلحات النقدية والبلاغية وتوليد بعضها من بعض.
ونختم حديثنا بأمثلة تطبيقية من القرآن الكريم زيادة في الفهم والتوضيح، وفي هذه الأمثلة تظهر خصائص الاعتدال والانسجام بين عناصر التناسب النثرية الأساسية المشار إليها سابقا، إن بشكل جزئي أو بشكل كلي، وخاصة عند الكتاب المتفننين المحترفين:
فمن الآيات القصيرة المتناسبة التي جاءت مبنية على كلمتين قوله تعالى: ( ياأيها المدثــر قم فأنذر وربك فكبــــر وثيابك فطهــــر..) سورة المدثر، وهي مكية.
وتخضع سورة المدثرفي معظم آياتها لنسق الجمل والفواصل القصيرة، وكذلك الشأن بالنسبة لمعظم السور المكية.
ونلاحظ في هذا المثال من سورة المدثر أن سجعة الراء التي لوناها بالأحمر ترد على الأذن في مسافات زمنية صوتية قصيرة جدا. وخاصية السجع القصير في الآيات المكية تتناسب مع طبيعة مضمونها وأسباب نزولها. حيث يتحقق منها إيقاع الرعب في نفوس المشركين بالتهديد بالنار، وبالوعيد بالويل والثبور.
وهذا بخلاف السور المدنية التي يغلب على فواصلها التفريع والتطويل وتفصيل أمور العبادات والمعاملات، خاصة بعد أن اطمأن الناس بالإسلام واستأنسوا به.
ونسق سورة المدثر القصير هذا، هو النسق السائد في الخطب الوعظية والسياسية والدينية وغيرها، وفي بعض أنواع النثر السردية، كالمقامات البديعية والحريرية المشهورة التي سندرسها بتفصيل في إدراجات لاحقة.
وامتدت عدوى السجع إلى النثر التأليفي أيضا، وخاصة في الكتابات التاريخية المسجعة التي اشتهر بها بعض المؤرخين وعلى رأسهم عماد الدين الأصفهاني الشهور بالعماد الكاتب، توفي سنة 597 هجرية.
وقد انتقد هذا النسق القصير من السجع بعض كتاب المغرب لصعوبته وكلفته من جهة، ولاشتباهه بالشعر من جهة ثانية. قال أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي الأندلسي في تعليل ذلك: ( وقصر الأسجاع محتقر مخل، وطولها المتفاوت مرذول ممل، فتكون وسطا، والمساواة بينهما عدل، لا كل المساواة، بحيث تخرج إلى الأوزان الشعرية). كتاب الدكتور ابن شريفة حول أبي المطرف، ص 218.
وأبو المطرف هذا عاش في القرن الهجري السابع، وتنقل بين العدوتين المغربية والأندلسية، وكتب لبعض سلاطين الدولة الموحدية والحفصية ولبعض ولاة الأندلس وأعيانها. وكان له باع طويل في كتابة الرسائل الإخوانية خاصة. غير أنه عندما امتـُحن بعمل المقامات أفحم واعترف بعجزه عن صنع مقامة واحدة واعتذر عن ذلك، في قصة معروفة، سنعرض لها في حينها.
أما ما جاء في القرآن الكريم من الآيات المتناسبة المبنية على ثلاث كلمات فمثل قوله تعالى:
( وآتيناهما الكتاب المستبيــــــن وهديناهما الصراط المستقيـــــم). سورة الصافات، 117 و 118.
ونلاحظ في هذا المثال من سورة الصافات أن كل كلمة في الجملة الأولى لها نظير في الجملة الثانية،على مستوى الحركات والميزان الصرفي. وقد أو ضحنا ذلك من خلال طريقة التلوين؛ فآتيناهما على وزن هديناهما، والكتاب على وزن الصراط، والمستبين على وزن المستقيم.
كما نلاحظ أن عدد الكلمات في الجملة الأولى هو نفس العدد الموجود في الجملة الثانية.
وهكذا يكون المثال الأول من قوله تعالى في سورة المدثر، قد جاء مزدوجا مسجوعا من غير موازنة، أما المثال الثاني من قوله تعالى في سورة الصافات فقد جاء مزدوجا متوازنا من غير سجع.
أما الآية السابقة من سورة الروم فقد جاءت مجنسة مسجوعة، من غير ازدواج أو موازنة، والجملة الثانية فيها زائدة عن الأولى بقدر كبير.
السجع
التجنيس، أو ( الجناس )
الموازنة
الازدواج
وهذه المكونات الأربعة إذا اجتمعت كلها، وكان السجع قائدها تحقق التناسب الكامل والتناغم العالي الرفيع بين أجزاء الكلام المنثور: الكبرى والوسطى والصغرى؛ ونقصد بالأجزاء الكبرى نظام الفقرات، وبالوسطى نظام الجمل والفواصل، وبالصغرى نظام الكلمات والحروف.
وقد حرص النقاد والبلاغيون في تعريفهم وتحديدهم لعناصر بلاغة النثر الرباعية تلك أي: ( السجع، التجنيس، الموازنة، الازدواج ) على تأكيد خاصية التناسب اللفظي والصوتي التي تتكامل وتتقوى بتعاونها، بحيث ينهض كل عنصر بقدر معين معلوم منها. وكأنه أحد عناصر العزف والإيقاع الموسيقي المنسجم المتناغم داخل الجوقة الموسيقية الواحدة، مهما اختلفت في تنوع مصادر إيقاعها، وفي طبقاتها الصوتية التي تعلو وتنخفض تارة، وتقوى وتضعف تارة أخرى.
أ ـ تعريف السجع:
( يكون الكلام مسجوعا بتواطؤ الفواصل النثرية على حرف واحد ). وهذا أقصر التعريفات التي تطالعنا في بعض كتب ضياء الدين بن الأثير الجزري ك( المثل السائر)، ج1/ ص333، و( الجامع الكبير)، ص 251. وابن الأثير أحد وجوه النقد والكتابة العربية في العصر الأيوبي، توفي سنة 637 هجرية.
والمراد بالتواطؤ هنا: التتابع المنتظم للسجعات من غير نقص وتقطع أو إخلال ونبو، ومن غير تغيير لحركاتها وسكناتها، كما في قوافي الشعر المتحدة الصافية عندما تخلو من عيوب القوافي البشعة المرذولة كالإيطاء والتضمين وغير ذلك، مما هو مقرر وثابت بالشواهد والأمثلة في كتب العروض والتقفية.
فنظام السجع في النثر إذن، له صلة كبيرة بنظام القوافي الشعرية، كما سنوضح لاحقا، عند حديثنا عن ضرورات السجع ومحظوراته التي لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها في الشعر.
وقد دافع ابن الأثير عن السجع دفاعا مستميتا، وانحاز إليه كثيرا في كتاباته النثرية الإنشائية التي ملأ بها كتبه النقدية والبلاغية، ورسائله الديوانية والخاصة. وهذا رغم اعتراضات المعترضين الكثيرة على ظاهرة السجع؛ بسبب ما شابها من وهم وخلط، وخاصة عند من التبس عليهم الأمر، وخلطوا بين نهي الرسول الكريم لبعض صحابته عن استعمال ( السجع النوعي ) أي: ( سجع الكهان) وبين ( السجع الفني ) كمصطلح بلاغي وظاهرة فنية صرفة.
أما سجع الكهان، فباعتباره نوعا نثريا قديما كان معروفا لدى العرب في نثرهم الجاهلي القديم. وكان مخصوصا بأهل الكهانة والعرافة ومحصورا في بيئتهم. وقد كان لخاصة الجاهليين وعامتهم، كما هو معروف، اعتقاد كبير في كلام الكهان المسجوع. وكانوا يخبرون به عن الغيبيات، تحت الطلب، ويدلسون بواسطته على الناس، فيما يشبه السحر والرموز المطلسمة.
وقد جـُبَّ هذا النوع بالإسلام لما فيه من ضلال وشرك، وخروج عن منهج التوحيد الإسلامي.
أما السجع الفني، فباعتباره حلية بلاغية جمالية مطلوبة، وظاهرة فنية خالصة مرغوبة، ولا يمكن أن تـُجَب أو تُحصر في زمان أو مكان.
وأمثلة السجع التطبيقية أكثر من أن تعد أو تحصى، وهي حاضرة بقوة في القرآن الكريم، بمستويات مختلفة، وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الخطب البليغة المحبرة، وفي الأمثال والأقوال المأثورة، وفي سائر النثر الإنشائي والتأليفي. بحيث إننا لا نبالغ إذا قلنا: إن السجع الفني يمثل الميزة الغالبة على الأساليب النثرية الرفيعة التي أشاعتها بلاغة الخطباء والمتحدثين الفصحاء، ورسختها أقلام كبار الكتاب والمنشئين.
ب ـ تعريف التجنيس، أو الجناس:
ذهب النقاد والبلاغيون في تعريف التجنيس وتقسيمه مذاهب شتى، ووضع بعضهم فيه كتبا مستقلة؛ ككتاب خليل بن أيبك الصفدي المشهور( جنان الجناس )، وقد أتى فيه على ما يقارب الستين قسما.
ومن التعاريف المختزلة للتجنيس: ( أن يكون تركيب الألفاظ في الكلام من جنس واحد ). ( المثل السائر)، ج1/ ص 142 و (الجامع الكبير)، ص 256.
والتجنيس في عرف البلاغيين اتحاد ( شكلي) كلي أو جزئي بين لفظتين أو أكثر داخل سياق الكلام؛ إما من جهة خط الحروف، أو من جهة شكلها وحركتها، أو من جهة نقطها أو إهمالها، مع اختلاف ( نوعي) في المعنى، كما في قوله تعالى: ( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة)، سورة الروم، الآية: 55. فمعنى ( الساعة ) الأولى يوم القيامة الموعود، ومعنى ( الــ ساعة ) الثانية: قدر الزمن الأرضي المعلوم.
ج ـ تعريف الموازنة:
الموازنة في النثر غير الوزن في الشعر، وهي هنا أقرب ما تكون إلى مفهوم الميزان الصرفي الذي يدرس أصول اشتقاق الكلمات العربية، ويضبط أوزانها القياسية والسماعية عند تحويلها من صيغها المصدرية إلى صيغها الفعلية.
فالموازنة في النثر تعني: توالي المفردات داخل الجمل والفواصل النثرية على نفس الميزان الصرفي، مما يتولد عنه تماثل في الحركات الإيقاعية وانتظام في المسافات الصوتية.
وقد دافع ابن الأثير أيضا عن خاصية الموازنة هذه، واعتبرها أساس الاعتدال في الكلام المنثور، قال في تعريف الموازنة وشرح خصائصها: ( الموازنة أن تكون ألفاظ الفواصل من الكلام المنثور متساوية في الوزن ، وللكلام بذلك طلاوة ورونق سببه الاعتدال، لأنه مطلوب في جميع الأشياء، وإذا كانت مقاطع الكلام معتدلة وقعت من النفس موقع الاستحسان). ( المثل السائر )،ج1/ ص 377.
والذي قصده ابن الأثير من الوزن هنا: الوزن الصرفي لا الوزن العروضي.
د ـ تعريف الازدواج:
ويكون الكلام مزدوجا ( إذا قسم إلى فقر متساوية ومتوازية في الطول أو القصر ). ( سر الفصاحة )، ص 165. وبعبارة أخرى أوضح أن يكون عدد الكلمات في الجملة النثرية الأولى مماثلا للعدد الموجود في الجملة الثانية، أولسائر الجمل المتتالية.
ولا ينبغي هنا أن تـَقصُر الفقرةُ أو الجملة النثرية الواحدة عن الأخرى كثيرا أو تطول عنها بقدر كبير، لكي يتحقق التناسب بصورة أكمل وأوضح، و( لئلا يبعد على السامع وجود القافية فتذهب اللذة) كما جاء في كتاب ( ثمرات الأوراق ) لابن حجة الحموي، ص 412.
وليس هناك حد ثابت لطول الجمل النثرية، خاصة إذا تداخلت في الجملة الكبرى الرئيسية جمل صغرى ثانوية. أما حد قِصرها فثابت ومعلوم؛ فأقصر ما تكون العبارة النثرية أن تتركب من كلمتين اثنتين، ولا يمكن أن تكون أقل من ذلك.
وكلما كانت العبارات النثرية قصيرة كلما اتضحت عناصر التناسب أكثر للسمع والبصر، وكان وقعها عليهما أكبر. وكلما طالت العبارات النثرية تبددت وحدتها وتشوهت ملامحها وضعف تأثيرها، وأشبهت الحديث اليومي العادي الذي يخلو، في الغالب، من التناسب والتنسيق إلا ما جاء عفو الخاطر.
ومما ينبغي الإشارة إليه أن وراء هذه التحديدات الأربعة البسيطة الرئيسية تفريعات تتعدد وتختلف باختلاف النقاد والبلاغيين في الزمان والمكان؛ فكثيرا ما مزج أصحاب البلاغة والبديع الأواخر بين تعريفهم لهذه العناصر البسيطة وتقسيمهم لها تقسيما جزئيا دقيقا، على عادتهم في تكثير المصطلحات النقدية والبلاغية وتوليد بعضها من بعض.
ونختم حديثنا بأمثلة تطبيقية من القرآن الكريم زيادة في الفهم والتوضيح، وفي هذه الأمثلة تظهر خصائص الاعتدال والانسجام بين عناصر التناسب النثرية الأساسية المشار إليها سابقا، إن بشكل جزئي أو بشكل كلي، وخاصة عند الكتاب المتفننين المحترفين:
فمن الآيات القصيرة المتناسبة التي جاءت مبنية على كلمتين قوله تعالى: ( ياأيها المدثــر قم فأنذر وربك فكبــــر وثيابك فطهــــر..) سورة المدثر، وهي مكية.
وتخضع سورة المدثرفي معظم آياتها لنسق الجمل والفواصل القصيرة، وكذلك الشأن بالنسبة لمعظم السور المكية.
ونلاحظ في هذا المثال من سورة المدثر أن سجعة الراء التي لوناها بالأحمر ترد على الأذن في مسافات زمنية صوتية قصيرة جدا. وخاصية السجع القصير في الآيات المكية تتناسب مع طبيعة مضمونها وأسباب نزولها. حيث يتحقق منها إيقاع الرعب في نفوس المشركين بالتهديد بالنار، وبالوعيد بالويل والثبور.
وهذا بخلاف السور المدنية التي يغلب على فواصلها التفريع والتطويل وتفصيل أمور العبادات والمعاملات، خاصة بعد أن اطمأن الناس بالإسلام واستأنسوا به.
ونسق سورة المدثر القصير هذا، هو النسق السائد في الخطب الوعظية والسياسية والدينية وغيرها، وفي بعض أنواع النثر السردية، كالمقامات البديعية والحريرية المشهورة التي سندرسها بتفصيل في إدراجات لاحقة.
وامتدت عدوى السجع إلى النثر التأليفي أيضا، وخاصة في الكتابات التاريخية المسجعة التي اشتهر بها بعض المؤرخين وعلى رأسهم عماد الدين الأصفهاني الشهور بالعماد الكاتب، توفي سنة 597 هجرية.
وقد انتقد هذا النسق القصير من السجع بعض كتاب المغرب لصعوبته وكلفته من جهة، ولاشتباهه بالشعر من جهة ثانية. قال أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي الأندلسي في تعليل ذلك: ( وقصر الأسجاع محتقر مخل، وطولها المتفاوت مرذول ممل، فتكون وسطا، والمساواة بينهما عدل، لا كل المساواة، بحيث تخرج إلى الأوزان الشعرية). كتاب الدكتور ابن شريفة حول أبي المطرف، ص 218.
وأبو المطرف هذا عاش في القرن الهجري السابع، وتنقل بين العدوتين المغربية والأندلسية، وكتب لبعض سلاطين الدولة الموحدية والحفصية ولبعض ولاة الأندلس وأعيانها. وكان له باع طويل في كتابة الرسائل الإخوانية خاصة. غير أنه عندما امتـُحن بعمل المقامات أفحم واعترف بعجزه عن صنع مقامة واحدة واعتذر عن ذلك، في قصة معروفة، سنعرض لها في حينها.
أما ما جاء في القرآن الكريم من الآيات المتناسبة المبنية على ثلاث كلمات فمثل قوله تعالى:
( وآتيناهما الكتاب المستبيــــــن وهديناهما الصراط المستقيـــــم). سورة الصافات، 117 و 118.
ونلاحظ في هذا المثال من سورة الصافات أن كل كلمة في الجملة الأولى لها نظير في الجملة الثانية،على مستوى الحركات والميزان الصرفي. وقد أو ضحنا ذلك من خلال طريقة التلوين؛ فآتيناهما على وزن هديناهما، والكتاب على وزن الصراط، والمستبين على وزن المستقيم.
كما نلاحظ أن عدد الكلمات في الجملة الأولى هو نفس العدد الموجود في الجملة الثانية.
وهكذا يكون المثال الأول من قوله تعالى في سورة المدثر، قد جاء مزدوجا مسجوعا من غير موازنة، أما المثال الثاني من قوله تعالى في سورة الصافات فقد جاء مزدوجا متوازنا من غير سجع.
أما الآية السابقة من سورة الروم فقد جاءت مجنسة مسجوعة، من غير ازدواج أو موازنة، والجملة الثانية فيها زائدة عن الأولى بقدر كبير.
يتبع........................
:10::10::10:
:10::10::10: